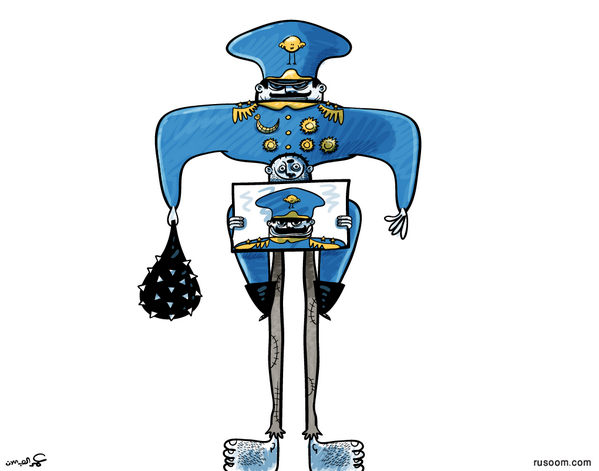مأزق اقتصاد السوق: انكشف الوهم أم سقطت اليوتوبيا؟

صبحي حديدي
رغم أجواء التشاؤم الحالكة التي كانت، وتظلّ، تشيعها مآزق المصارف والبورصات ومؤسسات الإقراض والتوفير والتأمين في أمريكا، وهنا وهناك في أنظمة اقتصاد السوق الأوروبية أو الآسيوية، كان طريفاً أن يطلع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على العالم بهذا الإعلانات الصاعقة: “اقتصاد السوق وهم”، و”مبدأ ’دعه يعمل’Laissez faire انتهى”، و”السوق كليّة الجبروت، التي كانت دائماً على حقّ، انتهت أيضاً”، و”من الضروري إعادة بناء كامل النظام التمويلي والمالي من الأسفل إلى الأعلى، على غرار ما جرى في بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية”…
كانت خطبة ساركوزي الدراماتيكية تلك، في مدينة تولون الفرنسية، أواخر الشهر الماضي، هي مساهمته الأولى في التعليق على الهزّة المالية الأمريكية، ليس من موقعه كرئيس لفرنسا فقط، بل كذلك لأنّ فرنسا تتولى رئاسة الإتحاد الأوروبي في الدورة الحالية. وإذا كان مفهوماً، أو منتظَراً تماماً، أن لا يحيد ساركوزي عن طبائعه الخطابية ـ المسرحية في مناسبة درامية مثل هذه، فإنّ وجه الطرافة إنما تمثّل في تلك الخفّة التي طبعت أحكام الإعدام ضدّ ركائز اقتصادية وفلسفية رأسمالية كانت عزيزة عليه على الدوام. كأنه، طيلة عمره السياسي ثمّ خلال الـ 20 شهراً ونيف بعد انتخابه رئيساً، لم يكن ملك الجعجعة والضجيج والعجيج حول اقتصاد السوق (لم يكن وهماً آنذاك!)، وضرورة تحرير السوق من كلّ القيود، وإفساح المدى الأقصى لاشتغال تلك القاعدة الكبرى الأشبه بالعجل الذهبي المقدّس: دعه يمرّ! دعه يعمل!
كذلك كان طريفاً أن يعود ساركوزي القهقرى إلى 64 سنة خلت، حين تمّ التوقيع على اتفاقيات بريتون وودز، في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، التي كان الإقتصادي البريطاني الشهير جون ماينور كينز أبرز مهندسيها، وأسفرت أساساً عن تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ذلك لأنّ روحية تلك الإتفاقيات تحديداً، أي صعود الهيمنة الأمريكية على أقدار الكون السياسية والإقتصادية والعسكرية، هي التي تتعرّض اليوم لارتجاج بنيوي عميق، يبرّر على نحو ما تلك التوصيفات الكابوسية للمأزق الراهن، في أنه أشبه بـ 11/9 أو بيرل هاربور على صعيد البورصات والأسواق.
ومن جانب آخر، ما تزال مؤسسات بريتون وودز، البنك والصندوق واتفاقيات الـ GATT ومنظمة التجارة الدولية فيما بعد، قائمة وفق الوظائف ذاتها التي سنّها لها حكماء الإقتصاد الرأسمالي سنة 1944، بل أشدّ سطوة ونفوذاً. كذلك فإنّ أدوارها في شلّ الإقتصادات الوطنية في عدد من البلدان النامية، وتحت ذريعة “الإصلاح الهيكيلي” الذي يجب أن يفضي قسراً إلى اقتصاد السوق، أخذة في التضخّم والتحكم والسيطرة. فبأيّ “إعادة بناء كاملة” لهذه المؤسسات يحلم ساركوزي اليوم؟ وأية فلسفة رأسمالية جديدة يمكن أن تنبعث من ركام تلك الفلسفات المتعاقبة التي تغنّت باقتصاد السوق، لكي تجد نفسها اليوم ملزمة بإعادة اعتناق نقيضه القاتل: التأميم، دون سواه!
فهل يطالبنا أمثال ساركوزي بأن نعيش حقبة ما بعد انهيار مصارف “وول ستريت” وبورصاته، تماماً كما طولبنا بأن نعيش في ما بعد 11 أيلول (سبتمبر) ، وما بعد الحرب الباردة، وما بعد الحداثة، وما بعد المجتمع الصناعي، وما بعد الإيديولوجيا، وما بعد الشيوعية، وما بعد التاريخ، وما بعد السياسة… حتى بات من النافل الحديث عمّا هو سابق، عن الـ «ما قبل»، أياً كانت الظواهر التي سبقته؟ كأنّ كل شيء حدث لتوّه، كما استغرب الباحث الأمريكي دافيد غريس في كتابه المثير «دراما الهوية الغربية»: العالم يخلع أرديته واحدة تلو الأخرى، من العقلانية والرومانتيكية والثورية، إلى تلك الرجعية والوثنية والمحافظة، مروراً بالليبرالية والرأسمالية والإشتراكية والشيوعية.
ولكن إذا توجّب، بالفعل، أن نعيش في حقبة الـ “ما بعد” المتغايرة المتتابعة هذه، فلماذا يتوجّب أن لا تكون هذه حقبة التبدّلات الكبرى التي تطرأ على ملفّات لاح أنها استقرّت أو رسخت أو انتصرت نهائياً، مثل بداهة العولمة، وحتمية اقتصاد السوق، وقدرية انكماش العالم إلى قرية صغيرة؟ ولماذا لا تكون حقبة ما بعد انهيارات “وول ستريت”، إسوة بشقيقتها ما بعد 11 أيلول، نذيراً باقتراب مراحل الـ «ما بعد» في هذه الأقانيم التي يتغنّى بها الغرب كلّ يوم: العولمة، اقتصاد السوق، العالم في هيئة قرية صغيرة؟
لن يكون هذا رأي المبشّرين القائلين بأنّ انتصار القِيَم الغربية ساعة سقوط جدار برلين هو في الآن ذاته انتصار لليوتوبيا الوحيدة المتبقية في حوزة الإنسانية، اليوتوبيا العليا والقصوى والأخيرة على هيئة «خاتم البشر» الذي بشّر به فرنسيس فوكوياما، واليوتوبيا التي يُراد لنا أن نسلّم بخلوّها تماماً من الأزمات والهزّات والتشوّهات. كأنّ التاريخ لم يعرف فترات الركود الرأسمالية الطاحنة، وكأنّ اقتصاد السوق الحرّ في إنكلترا (مهد ولادة هذا الإقتصاد وميدان تطبيقه الأوّل) لم تشهد آلام العيش اليوميّ في كنف سياسات مفقِرة وظالمة اجتماعياً، من اللورد بالمرستون إلى مارغريت ثاتشر.
ففي نظر هؤلاء المبشّرين لا يبرهن الإختراع الغربي للرأسمالية ـ وللعلم والأنوار والديمقراطية الليبرالية… ـ على نجاح منقطع النظير فحسب، بل هو يتقدّم حثيثاً لاجتياح العالم القديم والعالم الحديث في آن معاً، ما قبل الحرب الباردة وما بعدها، ما قبل الحداثة وما بعدها، ما قبل التاريخ وما بعده. أكثر من ذلك، لا يتردد هؤلاء في الجزم بأنّ القرن الحادي والعشرين سوف يكون أوّل قرون الرأسمالية الصافية الصرفة، إذا ما تذكّرنا أنّ القرن العشرين خالطته «شوائب» غير صغرى، مثل الشيوعية والنازية والفاشية والأصولية! فماذا يقولون اليوم في اعتلال هذا «القرن الرأسمالي الصافي»… بعد سنوات قليلة على تصفيته وتنقيته وتتطهيره؟
وأمّا إذا أشاح المرء بنظره بعيداً عن هذه المخططات الوردية للعالم القادم، وحدّق مليّاً في ما يجري اليوم بالذات في الولايات المتحدة وأوروبا، فإنّ الهويّة الغربية الظافرة يمكن أن تبدو ظافرة وقويّة ومدجّجة بالسلاح والعتاد والمال والأسواق، ولكنها ليست تلك الهوية الظافرة المطمئنة الآمنة. وفي قلب أوروبا، في البلقان التاريخي مهد الحروب والسلام، وفي جورجيا، وعلى تخوم ما تبقى من جغرافية الحرب الباردة القديمة، ثمة جولات مباغتة لا تهدأ الواحدة منها حتى تندلع الأخرى، في حروب إثنية ومذهبية قيل إنّ نهاية التاريخ قد أجهزت عليها مرّة وإلى الأبد. وهذه، في الجوهر العميق، أمثولة فاضحة حول حضارة غربية متخمة بالتكنولوجيا والعلم والليبرالية، ولكنها أيضاً مختنقة بمواكب اللاجئين والمشرّدين والجائعين والقتلى.
ألا يبدو المشهد الراهن ـ بين زلزال “وول ستريت”، وأوهام اقتصاد السوق كما باح بها ساركوزي، وما جرى وسيجري في جورجيا وأبخازيا ـ وكأنه ينسف تماماً صورة الهوية الغربية المعاصرة، التي خالت أنها سابحة بأمان واطمئنان في عوالم وردية من الرفاه والإستقرار والعلم والتكنولوجيا والليبرالية؟ ألا تبدو هذه المشاهد وكأنها استعادة طبق الأصل لكلّ أحقاب الـ «ما قبل» في السرديات الكبرى للحضارة الغربية، من اليونان القديم، إلى روما القديمة، إلى رحلة كريستوفر كولومبوس، إلى عصر الأنوار والحداثة، وصولاً إلى وقائع ما بعد انهيار الجدار؟
ألا نقول ما قيل مراراً، من أننا إزاء اهتزاز المشهد الغربي برّمته، خصوصاً مبادىء تلك الرؤية التي نهضت وتنهض على ثلاثة أقانيم جوهرية: 1) الرأسمالية، وقداسة اقتصاد السوق؛ و2) حقوق الإنسان، شرط أن تقترن وجوباً بالقراءة الغربية لها؛ و3) إطار الأمّة ـ الدولة، كصيغة هوية معتمدة في العلاقات الدولية؟ وهذه الأقانيم بالذات ألا ترتدي هيئة مختلفة تماماً كلّما تعلّق الأمر بمجتمعات وثقافات العالم غير الغربي، الأمر الذي ظلّ يفتح باب الإجتهاد حول تصارع حضاري ـ ديني على طريقة صمويل هتنغتون، أو توتّر هيلليني ـ آسيوي على طريقة برنارد لويس، أو ولادة «الأيديولوجية التالية» على طريقة غراهام فوللر كما بشّر بها في كتابه الشهير «مصيدة الديمقراطية: أخطار العالم ما بعد الحرب الباردة»؟
الـ «ما بعد»، إذاً، هو أيضاً هذه اليقظة البربرية، وهذا الإنهيار في مبدأ الإستراحة الستراتيجية للمحارب القديم، وهذه الجولة المباغتة في حروب قيل لنا أنها انقرضت مرّة وإلى الأبد، وفي حروب أخرى لم يكن العقل البشري يسمح بتداول سيناريوهاتها إلا في روايات الخيال العلمي وأفلام الكوارث. إنها، أيضاً، عاقبة شبه حتمية لعجز مجتمعات ما بعد الحرب الباردة عن التلاؤم مع الأقانيم الغربية الظافرة أولاً؛ ثمّ سعي تلك المجتمعات إلى صياغة أقانيمها الخاصة، التي لا بدّ أن تدخل في تناحر واسع النطاق مع القِيَم التي تدعو إليها دول ومجتمعات وأنظمة سياسية ـ اقتصادية تنسب إلى ذاتها وظيفة، وتحتكر حقّ، إدارة المعمورة.
بيد أنّ فوللر لم يترك هامشاً للريبة في أن الإيديولوجيا التالية التي ستواجه الغرب لن تكون بديلاً واضحاً صافياً، بل ستكون مزيجاً مركباً من رفض «التحديث» بمعناه الغربي، وتوطيد الإنشقاقات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. وأما السيناريو الأسوأ، في نظره، فسوف يكون ذهاب أتباع تلك الأيديولوجيا إلى حدّ المطالبة بقيادة الكون (أو حصّتهم من ذلك الكون) وتنحية المركز الغربي الذي يتزعم وينسّق ويحفظ توازنات العالم. الجانب الكابوسي الآخر في السيناريو الذي رسمه فوللر، كان ذاك المتعلّق بمراكز أخرى في ما تبقّى من بلدان العالم الثالث، تلك التي سوف تظلّ على المدى المتوسط والبعيد حاملة لجرثومة الماضي وضغوطات قرن كامل من رفض الحداثة. ذلك يعني أن النجاحات لن تفلح في تطويع «الإنتفاضات السوداء»، كما يسمّيها، والتحام المعضلات الديموغرافية بمعضلات الهجرة والإفقار المتزايد والتصحّر والمجاعات، ثم تَبَلْوُر ذلك كله في خطابات أصولية تنهض في أرض ممهدة، وتترعرع في وجدان جمعي جريح وجاهز لاستقبالها واحتضانها.
وهو لا يغفل الإشارة إلى التهديد الذي تتعرّض له الثقافات الوطنية بفعل التعميم القسري للقِيَم الغربية، وبوسائط تبادل لا قِبَل لتلك المجتمعات بمقاومتها. ولكنّ طبيعة ونطاق هذا التهديد تقتضي وقفة معمّقة عند ذلك التصدير الأخطبوطي الجبّار للسلعة الثقافية (الكتاب والفيلم والأغنية ونوع الطعام واللباس والدواء)؛ وصناعة الرمز الثقافي الأشبه بالأسطورة في ذلك كله، بحيث تتحوّل شطيرة الـ «بيغ ماك» إلى رمز للجبروت الأمريكي السياسي والاإتصادي والعسكري، ليس في بلد مثل ماليزيا فحسب، بل حتى في بلد مثل فرنسا أيضاً. ألا يتفق الجميع على أنّ العمليات الإنتحارية ليوم 11/9 استهدفت تدمير رموز الجبروت الأمريكية، وأنّ سقوط الرموز أسفر عن مسّ خطير بمنعة وحصانة وأمان آلة الجبروت ذاتها، الإقتصادية أوّلاً (شركات الطيران، البورصة، مناخات الإستثمار، الأشغال والوظائف)، والعسكرية ثانياً واستطراداً؟
وبالطبع، يبقى ذلك الترجيح الذي يقول إنّ النظام الغربي التقليدي، الذي حقّق انتصاراً على ذاته بعد انهيار جدار برلين، لن يتمكن من إعادة تصنيع ذاته المعولَمة، فضلاً عن تلك المعولِمة، بيدٍ تفتح بوّابات اقتصاد السوق، وأخرى تغلقها في خضمّ مسمّى “الحرب على الإرهاب”. هنا صناعة أوهام من طراز آخر، وهي لا تختلف عن الطراز الساركوزي، في رثاء السوق الراهنة ونوستالجيا بريتون وودز، إلا في أنها تؤكد سقوط اليوتوبيا… بعد انكشاف الوهم!
خاص – صفحات سورية –