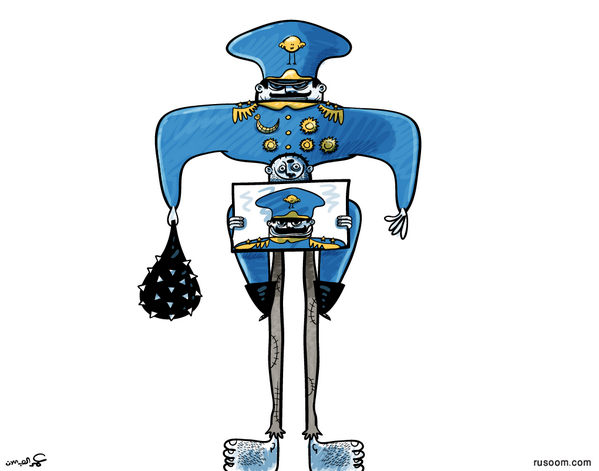حرب غزة: ثمن إسرائيلي فادح لقاء ظفر حمساوي معلن

صبحي حديدي
بين 450 رئيساً للكليات والجامعات الأمريكية، ممّن اعتادوا استنكار وإدانة جهود بعض الأكاديميين البريطانيين لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية، لا أحد من هؤلاء نبس ببنت شفة، أو كتب كلمة واحدة، في إدانة أو استنكار القصف الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف الجامعة الإسلامية في غزّة، على امتداد ستّ غارات. ورغم أنّ الجامعة تظلّ رمزاً ثقافياً وتربوياً حمساوياً (تأسست سنة 1978على يد حركة ‘حماس’، ولكن بموافقة سلطات الإحتلال الإسرائيلية… للمفارقة)، فإنها في نهاية المطاف جامعة في عداد جامعات الأرض: إنها مؤسسة التعليم العالي الأهمّ في غزّة، سيما حين يستذكر المرء حقيقة أنّ سلطات الإحتلال تحظر على طلاب غزّة الدراسة في الضفة الغربية أو الخارج، ولهذا يدرس فيها قرابة 20 ألف طالب، تشكل النساء نسبة 60 ‘ منهم، وتضمّ 10 كليات ليست جميعها في اختصاصات الشريعة والفقه الإسلامي، إذ ثمة كليات للطبّ والهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتمريض.
إذاً، وبعد أن يضع المرء جانباً ذلك الصمت الشائن واللاأخلاقي الذي يمارسه الساسة، والغالبية الساحقة من المعلّقين والكتّاب والصحافيين هنا وهناك في أوروبا والولايات المتحدة، ها هو النموذج الأكاديمي يتولى اختصار باركة جرائم الحرب الإسرائيلية في غزّة. ولعلّ مما يلفت الإنتباه أنّ أوّل استنكار لهذا القصف جاء من الأكاديمي الإسرائيلي نيف غوردون، رئيس كلية السياسة والحكم في جامعة بن غوريون، النقب، وصاحب الكتاب المتميز ‘الإحتلال الإسرائيلي’ الذي صدر السنة الماضية، وأحد محرّري التقرير الشهير ‘التعذيب، حقوق الإنسان، الأخلاق الطبية، والحالة الإسرائيلية’، 1995.
وإذْ يًظهر استطلاع للرأي، نشرته بالأمس صحيفة ‘هآرتز’، أنّ 52′ من الإسرائيليين يؤيدون استمرار عمليات القصف الجوّي ضدّ غزّة، ويدعو 19’ إلى رفد هذه العمليات بهجوم برّي، فإنّ أمثال غوردون لا يقبعون في صفّ أقلية الأقلية فحسب، بل هم في عداد ‘الإسرائيليين كارهي إسرائيل’ حسب ابن جلدتهم أري شافيت، المعلّق السياسي الشهير. صحيح أنّ عملية ‘الرصاص المسبوك’ مأساوية لأنها تقتل النساء والأطفال أيضاً، يقول شافيت، ولكنها من جهة أخرى حملة عسكرية عادلة، ولا بدّ لكلّ الحروب من أن تنطوي على المآسي. أمّا ما يتشدّق به إسرائيليون كارهون لإسرائيل، فإنه حسب شافيتز… لا يعين الفلسطينيين، الأحرار والمعتدلين ومحبّي السلام!
أين يمكن العثور على أمثال هؤلاء الفلسطينيين؟ ياسر عبد ربه؟ نبيل عمرو؟ محمد دحلان؟ أم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي استخدم صفة ‘الحقيرة’ في وصف المجازر الإسرائيلية في بيت حانون قبل سنتين، تماماً كما وصف عملية استشهادية فلسطينية قبلها بأسابيع معدودات؟ وفي ربيع العام ذاته، 2006، حين أغار الجيش الإسرائيلي على سجن أريحا (التي لا تقع في غزّة، وليست البتة تحت سيطرة ‘حماس’، ولا تنطلق منها صواريخ القسّام…)، فأهان حرّاس السجن والسجناء الفلسطينيين بإخراجهم عراة أمام الكاميرات، قبل اعتقال الأمين العام لـ’الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين’ ورفاقه… ماذا قال عباس في وصف هذا كلّه: ‘جريمة لا يمكن أن تغتفر’!
لعلّ هؤلاء هم الذين في ذهن المعلّق شافيت، مقابل امّحاء مجازر بيت حانون ومهانة سجن أريحا، وسواها من الجرائم الإسرائيلية، من الذاكرة إياها التي تطلب من الإسرائيليين كارهي إسرائيل أن لا يعينوا نقائض عباس وعبد ربه وعمرو ودحلان. والحال أنّ شافيت كان يردّ مباشرة على جدعون ليفي، زميله في ‘هآرتز’، لأنّ الأخير وصف عمليات قصف غزّة بـ ‘السبت الاسود’، وتحدّث عن غياب أيّ معنى عسكري مهني أو بطولي في إرسال الطيارين الإسرائيليين لقصف مواقع على الأرض تفتقد إلى القدرة على القيام بأي ردّ عسكري مضادّ، بحيث لا تختلف هذه العمليات عن تلك التي يقوم بها الطيارون أثناء التدريب بالذخيرة الحيّة. وأمّا إثم جدعون الأكبر فإنه، بعد أن حفظ للطيارين حقيقة أنهم إنما ينفّذون الأوامر العسكرية، اعتبرهم في عداد ‘المتعاقدين الفرعيين’، وطرح عليهم السؤال الشاقّ: ‘ألا يفكّرون في الحقد المشتعل الذي يزرعونه في النفوس، ليس في غزّة وحدها بل في أماكن اخرى من العالم، في غمرة المشاهد المريعة على شاشات التلفزة’؟
قبل شافيت، وفي الصحيفة ذاتها التي تفاخر بأنها ليبرالية أو تمثّل يسار الوسط، كتب يويل ماركوس، الذي اعتاد التحذير من التورّط في غزّة حتى أنه اعتبرها فييتنام إسرائيل: ‘لن أخفي ابتهاجي لمشاهد اللهيب والدخان يتصاعد من غزة، والتي أمطرتنا بها شاشات التلفزة. لقد آن الأوان لكي ترتعش نفوسهم ذعراً فيفهموا أنّ استفزازاتهم الدموية ضدّ إسرائيل لها ثمنها’. وهكذا فإنّ الهمجية الإسرائيلية ضدّ غزّة اليوم تستكمل الحلقات الهمجية التي تعاقبت منذ تأسيس الدولة العبرية، وتدخل في قلب المزاج الدامي والدموي الذي جعل، ويجعل كلّ يوم، سواد الإسرائيليين آلة فتك وآلة كابوس وآلة وجود في آن معاً. وهو مزاج أهوج أعمى، متطرّف وعنصري وبربري، يقتات على الدم الحيّ تارة، مختلطاً بالدخان والدمار واللهيب الذي يبتهج له ماركوس، أو يتغذى طوراً على صورة فلسطيني يزداد زجّه في صورة الآدمي اللامرئي الذي لا يُرى، إذا بان واستبان، إلا في صورة الإرهابي القاتل الإسلامي المتشدد الحمساوي، الذي انفكّ عن كلّ عقل واعتدال. وغزّة اليوم، مثل بيت حانون أو سجن أريحا في الأمس القريب، لا تتنزّل في مستقرّ آخر سوى هذا الإنفلات الفاشيّ الوحشي لدولة لم تعد تحفظ من ذاكرة الهولوكوست سوى إعادة إنتاجه بين حين وآخر، فتستوي غزّة مع بيروت، وبيت حانون مع بنت جبيل…
وكان الروائي والكاتب الإسرائيلي دافيد غروسمان (الذي، للتذكير، فقد ابنه أوري ابن الـ 20 سنة والضابط الإحتياط في سلاح المدرعات، أواخر العدوان الإسرائيلي على لبنان) قد أقرّ بأنّ الازمة التي تعيشها الدولة العبرية ‘أشدّ عمقاً مما كنّا نخشى في أيّ يوم، وفي كلّ منحى’. كان غروسمان يلقي خطبة في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، وأوضح أنه ‘يحمل لهذه الأرض محبّة هائلة وطاغية ومركبة’. وهو علماني التفكير، ولكنه مؤمن بأنّ قيام دولة إسرائيل كان ‘معجزة من نوع ما، سياسية ووطنية وإنسانية، وقعت لنا كأمّة’. وكان غروسمان بحاجة إلى تشديد كهذا، مشبوب غنائي واقعي ـ ميتافيزيقي في آن معاً، لكي يبلغ سلسلة خلاصات كارثية من الطراز التالي:
ـ ‘هذا وطن جعل كارثتي الشخصية بمثابة ‘ميثاق دموي’؛ و’طيلة سنوات كثيرة، لم تفرّط إسرائيل في دماء أبنائها فحسب، بل فرّطت في المعجزة ذاتها، وفي فرص بناء دولة ديمقراطية ناجحة، تلتزم بالقِيَم اليهودية والكونية’؛
ـ ‘كيف حلّ بنا هذا؟ متى فقدنا حتى الأمل في أننا سنكون ذات يوم قادرين على تأمين حياة مختلفة أفضل؟ وكيف حدث أننا نواصل التفرّج كلّ على حدة، كأننا نُوّمنا مغناطيسياً بفعل الجنون والوقاحة والعنف والعنصرية التي حاقت بوطننا؟’؛
ـ ‘أحد أكثر نتائج الحرب الأخيرة صعوبة هو الإحساس المتعاظم بأنه لا يوجد ملك في إسرائيل، وأنّ قيادتنا جوفاء، قيادتنا السياسية والعسكرية جوفاء. لست أتحدّث عن أخطاء إدارة الحرب، أو انهيار الجبهة الداخلية، أو الفساد واسع النطاق. إنني أتحدث عن حقيقة أنّ الناس الذين يقودون إسرائيل اليوم عاجزون عن ربط الإسرائيليين بهويتهم، وبتلك المساحة والذاكرة التي تمنحنا الأمل والقوّة، وتضفي بعض المعنى على صراعنا اليائس الواهن من أجل البقاء’…
وفي التعليق على مجازر غزّة، لا يبدو أنّ هذه الصورة الكابوسية تتلبس غروسمان إذْ ينصح قادة إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، من جانب واحد، بهدف إقناع ‘حماس’ بأنّ الضربات التي كانت شديدة يمكن أن تصبح أشدّ إذا استؤنفت! صحيح أنه يطالب، بلغة حازمة، أن تدرك إسرائيل بدقّة متى يتوجب على قوّتها الردعية الجبارة أن تلزم حدّها، إلا أنه يميل إلى اعتماد ذات المعادلة الرائجة، الفاسدة الزائفة: استفزاز صاروخي من ‘حماس’، مقابل ردّ فعل دفاعي من إسرائيل. غير أنّ معلقاً مخضرماً مثل البريطاني روبرت فيسك لا يرى ضيراً في تذكير العالم بالمقارنة التالية، رغم محتواها المأساوي على الجانبين: ‘صواريخ حماس محلية الصنع، ولم تؤدّ إلا الى مقتل 20 إسرائيلياً فقط خلال 8 سنوات. غير أنّ هجوماً بالطائرات الإسرائيلية ليوم واحد، أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 فلسطيني’!
وهذا يعيدنا إلى معلّق إسرائيلي آخر هو ألوف بِنْ، الذي عقد مقارنة إفتراضية بين صاروخ فلسطيني من طراز ‘القسام’، محمّل بمواد إنفجارية بدائية، يسقط على سيدروت أو عسقلان ويتسبب في أضرار طفيفة لا تتجاوز جرح مستوطن أو حفر طريق إسفلتي؛ وصاروخ سوفييتي الصنع من طراز ‘سكود’، محمّل برأس كيماوي، يمكن أن ينطلق من نقطة ما على الجبهة السورية، فيسقط على تل أبيب ويوقع مئات الإصابات. وتوصّل بن إلى خلاصة قد تبدو بالغة الغرابة، للوهلة الأولى فقط: أنّ الصاروخ الأوّل، ‘القسام’ هو الأشدّ خطورة. ذلك لأنّ احتمال إطلاق الـ ‘سكود’ يبدو بعيداً أو حتى مستبعداً، إذ يعرف بشار الأسد أنّ عواقب إطلاقه سوف تعني قيام مقاتلات إسرائيلية من طراز F-16 بدكّ مواقع السلطة السورية أينما كانت، بدءاً من القصور الرئاسية، وصولاً إلى مختلف المقرّات والمواقع الامنية، وتهديد أمن النظام في الصميم).
ليست المشكلة، إذاً، في التكنولوجيا التدميرية للصاروخ، أو الأمدية التي يمكن أن يبلغها، بل في القرار السياسي خلف الأصابع التي تضغط على زرّ الإطلاق. وبهذا المعنى، استخلص بن أنّ الأسد أرحم للدولة العبرية من فتية كتائب عزّ الدين القسّام، وصاروخه الفتاك أقلّ وطأة من صواريخ الهواة التي يصنّعونها بموادّ بدائية وتكنولوجيا فقيرة. والمرء يتذكر أن حكومة إيهود أولمرت أعادت، صيف 2006، إحتلال ثلاث مستوطنات سبق للجيش الإسرائيلي أن أخلاها قبل نحو عام، بقرار من رئيس الوزراء السابق أرييل شارون. وكان الهدف تكتيكياً وستراتيجياً معاً، يسعى إلى تشكيل مناطق عازلة شمال قطاع غزّة، تحول دون وصول صواريخ القسام إلى عمق، أو حتى إلى تخوم، سديروت وعسقلان داخل ما تسمّيه الدولة العبرية بـ ‘الحزام الأمني’. لكنّ سقوط ‘قسام’ جديد في قلب عسقلان، بعد احتلال المستوطنات الثلاث وتوسيع رقعة المناطق العازلة، أعاد العملية بأسرها إلى السؤال الأمّ: هل يتوجّب إعادة احتلال غزّة، والعودة إلى المربع الأوّل الجهنمي الذي غادره شارون على عجل وبلا ندم؟ وأيّ ثمن فادح يتوجب على الدولة العبرية أن تسدده لقاء هذه العودة ـ الردّة؟
الأرجح أنّ هذا السؤال هو اليوم الأشدّ إلحاحاً على القيادات الإسرائيلية، قبل أغراض أخرى تخصّ تحسين المواقع الشخصية والحزبية قبيل انتخابات الكنيست، أو تعكير صفو الأشغال الإيرانية الإقليمية، أو اللعب المباشر في تجاذبات المحاور العربية، أو اختراق استحقاقات فلسطينية داخلية على رأسها انتهاء شرعية محمود عباس الرئاسية في التاسع من هذا الشهر، ومؤتمر حركة ‘فتح’ المعطّل، وسواها. وإذا صحّ هذا التشخيص، فإنّ ‘حماس’ قد خرجت ظافرة لتوّها، حتى قبل أن تتضح طبيعة المغانم السياسية!
‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
خاص – صفحات سورية –