كيف استقبل الكتّاب الفرنسيون إعلان الحرب العالمية الثانية في صيف 1939؟
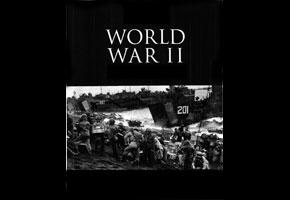
اعداد: كوليت مرشليان
صيف 1939: موعد حاسم تستذكره الصحافة الفرنسية باحتفالية وذكريات ووقائع عنوانها العريض: “70 عاماً على بداية الحرب العالمية الثانية”، وتطرح أسئلة من نوع: حين كان الزعيم النازي أدولف هتلر يجتمع مع حلفائه في برلين لاتخاذ قرارات عسكرية مصيرية، ماذا كانت فرنسا تفعل؟ في برلين كان القرار: الحرب غداً، وفرنسا كانت تلهو. وقد طرحت مجلة “لوبوان” الفرنسية تفاصيل الموضوع في ملف طويل رصدت فيه اللحظات الحاسمة: 31 آب 1939، من كان يغني؟ من كان يقدم عروضاً مميزة؟ كيف كانت شواطئ فرنسا تعج بالسواح… وفي أسلوب ممتع يروي الملف ويصف أحداث ذاك اليوم الذي سبق الحرب: تلك الليلة، غنى شارل ترينيه فرنسا الثلاثينات. وفي أمسية امتدت الى منتصف الليل صفق له الحضور طويلاً وودع الخشبة مع غيره لفترة طويلة… وعلى شاطئ الكارلتون، كان بعض المتحمسين يعيد بناء “كاتدرائية باريس” بالكرتون والمعجون اللاصق ويتجمهر السيّاح من حولها في احتفالية صيفية تضج برائحة البحر، كذلك في تلك الليلة كان افتتاح الفيلم “أحدب نوتردام” مع شارل لوتون وبه افتتح “مهرجان كان” الأول والذي كان ينتظره الفرنسيون منذ زمن. امتدت ليلة افتتاح المهرجان في دورته الأولى حتى الصباح ولم يعرف الفرنسيون أنها ستكون ليلة رهيبة إذ أنه مع الصباح سمع الجميع أن هتلر اجتاح بولونيا… ومع ذاك الواقع تغيّر كل شيء: أعيد هدم الكاتدرائية الكرتونية وألغيت الحفلات كما توقف افتتاح “مهرجان كان”: إنتهى العيد وبدأت الحرب.
ويضيء الملف على عدد من الكتّاب والأدباء الفرنسيين ويطرح السؤال: أيلول 1939، في تلك الأيام القليلة التي شهدت أحداثاً مصيرية، ماذا كان يفعل الكتاب والأدباء؟ ماذا كتبوا أو ماذا ألغوا من مشاريعهم؟ وإذا كان البعض قد أوقف نشاطه مثل جوليان غرين أو جان جيونو الذين أوقفوا صدور صحيفتين يترأسانها، فإن عدداً كبيراً من الكتّاب استمر في نشاطه:
[ سيمون دو بوفوار:رافقت الجندي جان بول سارتر
في 2 أيلول، في الساعة الثالثة فجراً، رافقت الجندي جان بول سارتر الذي تحرك بقوة مع الحدث وكتبت تصف تلك الليلة: “كانت الساحة فارغة تحت ضوء القمر مع جنديين فقط. كان المشهد أشبه بإحدى روايات كافكا وشهدت سارتر يتقدم وحيداً بخطوات حرة ومجانية مع إحساس عميق لديه بالقدرية العميقة المتأتية من داخل… وفي الواقع، استقبل الجنديان بلطف وببعض اللامبالاة هذا الرجل الصغير القامة الذي كان يتقدم نحوهما وقالا له ببساطة: “هيا، تقدم نحو محطة الشرق”.
في 3 أيلول: … “وجدت نفسي أعود الى منزلي دامعة العينين وبدأت بتوضيب أغراضي بطريقة تلقائية: غليونه وملابسه… وشعرت بأنني حتماً لن أعيش إذا هو مات. كذلك شعرت بالخوف على جاك. ب (جاك بوست، عشيقها بعد حين). (المقتطف من “مذكرات حرب”، صدر عن غاليمار لبوفوار).
[ جان ـ بول سارتر: الى لويز فيدرين(عشيقته)
كتب لها سارتر في 2 أيلول:
“إذاً كانت الغلبة أخيراً لهؤلاء السفلة، يا حبيبتي، فلست خائفاً على حياتي كما لست خائفاً من العذاب، كما لا ألوم كثيراً “مون كاستور” (أي سيمون دو بوفوار) لأنها تمتلك الشجاعة والكمال، كما كانت دائماً: إنما ما يمزق قلبي، هو أن أرحل من دون أن أودعكِ(…) إنها قصة وسخة في حياتنا، لكنها لن تكون نهاية حياتنا. سيكون هناك سلام… (رسائل الى “كاستور” وآخرين…)
[ أندريه موروا: كنت في المكتب وبدأت الحرب
كنتُ متواجداً في مكتب موريز (مساعد جان جيرودو) وكان ذلك يوم الأحد 3 أيلول في الساعة الخامسة بعد الظهر حين صدر القرار وبدأت الحرب. وحين كانت الطلقات الخمس تدوي، أمسكنا بأيدي بعضنا: “إنها الدقيقة الأولى للحرب”، قال لي موريز… ولا تنسوا أبداً أننا أمضيناها سوية…” في المساء، دعاني جيرودو الى مكتبه، وحين سأله أحدهم حول ماذا يمكن للمخيلة أن تصنع إزاء “إختراعات” هتلر، أجاب: “سيروس الكبير”! (وهو عنوان رواية للكاتبة دو سكوديري). أعجبتني إجابته ولكن فانتازية ووقاحة الفرنسي والأكثر فرنسية على الإطلاق، هل ستنجحان؟ (من “مذكرات” لموروا، عن فلاماريون).
[ لويس ـ فاردينان سيلين: من دون مدخول
وقعت علينا تلك البشاعة الرهيبة كالصاعقة العنيفة وغير المتوقعة الى درجة أنني شعرت بعدم التوازن لأيام عديدة. وذلك لأنني قبل أي شيء سأجد نفسي من دون مدخول، لا أدبي ولا غيره. كما أنه لدي ثلاثة أشخاص على عاتقي ومسؤوليتي. أحاول أن أقوم بعمل ما هنا في (سان. جيرمان. ان. لاي) لكن البدايات، حتى مع الحروب، هي دائماً صعبة. في نهاية المطاف، إنه فصل جديد في تلك القيامة المتوقعة. وسوف نرى.
(“رسائل الى ماري كانافاجيا” ـ صادر عن “غاليمار”).
[ جان كوكتو: ذهب جان ماريه الى الحرب
تحرك الممثل جان ماريه ليلتحق بالجيش في 2 أيلول. إنهار جان كوكتو وراح يضاعف رسائله، منها الرسالة الموقعة بتاريخ 3 أيلول: “في ما يتعلق بسيارتي، عليكَ أن تُبقيها معكَ. إذن أطلب أمر استلامها من القادة لديك ثم أرسل ورقة الإستلام…
(“رسائل الى جان ماريه” صادرة عن “البان ميشال”).
[ فرنسوا مورياك:
في العزلة التي أعيش فيها، تلقيت “ضربة البوكر الألمانية” بصدمة… لم يعد لدي سوى أن أنتظر وأطلب من الله أن تمر الأمور بسلام..
(رسالة الى اندريه جيد من “مراسلات”، عن “غاليمار”).
[ اندريه جيد: اقرأ “آتالي”!
“الحرب هنا.. ولأتمكن من أن افلت من هاجسها، أعيد قراءة مقاطع من “فايدر” و”آتالي” وأحاول ان احفظها غيباً
(من “مذكرات” عن “غاليمار”).
[ جورج سيمونون: ترقرت الدموع!
بعد ان علم باعلان بداية الحرب وقد سمعته من “بيسترو دولا روشيل”، عاد سيمونون الى منزله وكتب:”من أجل ان نبعد عنا الأفكار السوداء، ذهبت وفتحت القناني المتبقية من حفل العمادة الماضية، وشربنا نخباًَ ليس من أجل الاحتفال انما من أجل الحصول على شيء من الشجاعة للتطلع الى المستقبل امامنا. وحين شربنا، شعرنا جميعنا بأن الدموع ترقرقت في عيوننا. وهل سيتركوننا وشأننا في نهاية المطاف؟
(من “مذكرات حميمة” صادرة عن “بريس دولاسيته”).
[ “بيار دريّو لا روشيل”: لم يحدث اي شيء!
في 9 ايلول كتب لاروشيل (وكان مدير احدى الصحف التي بقي فيها حتى تاريخ انتحاره في العام 1945 ما معناه: “اكتب هذا (بعض الآراء حول عشيقاته) لأقول بأنه لم يحدث اي شيء يذكر. وذلك لأن اوروبا ناضجة كفاية لتقع تحت تأثير هذه الهيمنة العسكرية.
ولدى الشعوب المتخلفة يكون العنصر العسكري هو الأساسي لأنه اي انتصار للقوى العسكرية يسيطر على كل العناصر الضعيفة الأخرى”..
(من “مذكرات 1939 ـ 1945” ـ صادرة عن “غاليمار”).
[ بول كلوديل: جيش يضم وحوشاً
الأحد، 3 ايلول: “.. احتل الألمان “زتوشووا” وأحرقوها (وهو مكان يحج اليه المسيحيون وفيه تمثال العذراء السوداء) (..) انهم مجرد جيش يضم وحوشاً ضارية يقودها مسؤولون دمويون متوحشون”..
(من “مذكرات”، صادرة عن “غاليمار”).
[ البير كامو: الأمل لم يعد ممكناً
“رجال 1914 لم يملكوا اسباباً اكثر مما نملكها نحن لكي يخضعوا الى قدرهم. كانوا يظنون انهم يقومون بتلك الحرب وأنها ستكون الأخيرة. نحن لا يمكن ان نملك هذا الأمل. وفي هذه الساعة المميتة، اذا اردنا ان ننظر بأمل فليس الى مستقبلنا بل الى صور قيّمة من ماضينا حين كانت الحياة تحتفظ بمعناها الحقيقي: سعادات الأجساد في العاب الشمس والماء، اخوة الناس في هدف مشترك، هذا وحده كان له قيمة. وحتى اليوم هذا وحده له قيمة، لكنه لم يعد ممكناً.
(من صحيفة جزائرية: “المساء الجمهوري”).
[ جورج برنانوس: لم يعد من مكان لنا
“نعود الى الحرب تماما كما نعود الى منازل شبابنا.. ولكن لم يعد هناك من مكان لنا”.. (..) لقد افرغوا الخزانات ورموا من النوافذ كل ذكرياتنا وموتانا، هكذا كيفما كان وهم يحرقونهم وسط ساحاتنا..”.
(من “الأولاد والاهانة” عن “غاليمار”).
[ لويس اراغون: في السفارة التشيلية
بعد ان تعرض للعنف من قبل أشخاص من صفوف اليمين المتطرف بعد الاتفاق الألماني ـ السوفياتي، توقف صدور صحيفة “هذا المساء” وراح يسكن لدى صديقه بابلو نيرودا في سفارة التشيللي. وقبيل توقيفه، انهى اراغون روايته التي تتحدث عن شاب يشارك في حرب 1914. وهذه آخر السطور من الرواية كتبها اراغون في 31 آب 1939: “أجل، ولكن انجي جانو، لن ولن يعرف الحرب”!..
(من “مسافرو الامبراطورية”، صدرت عن “غاليمار”).
[ مارغريت دوراس: اريد ان أتزوجك!
“اريد ان أتزوجك. عد الى باريس. توقف. مارغريت: (تيليغرام ارسلته مارغريت دوراس الى روبير آنتيلم الذي تجند في روان، وتاريخ التيليغرام: 3 ايلول 1939).
[ جوزف كيسيل:
ما هي مهنتك؟
تجند في الصفوف الثانوية في بروفانس (ساين ـ اي ـ مارن).
ـ ما هي مهنتك؟ سأله الكابورال
ـ أنا صحافي وكاتب.
ـ اذا يا صديقي، انت تصلح للمعول
ـ لماذا؟
ـ لأنه فوق ورقتك بدلا من “جورناليست” كُتب “جورناليه” حسناً، من بعده..
مشهد من 3 ايلول 1939 سرده الصديق ايف كوريير في كتابه “جوزف كيسيل او فوق منصة الاسد”)
المستقبل




