زكريا محمد: لا يصبح الشعر شعراً بالكتابة بل بالحذف
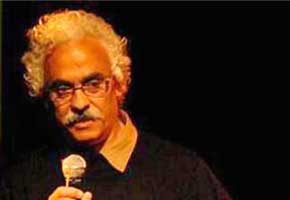
بيروت – حسين بن حمزة: زكريا محمد صوت خافت في الشعر الفلسطيني والعربي. بدأ النشر بمجموعة أولى حملت عنوناً ضدياً: “قصائد أخيرة”. وتزامن ذلك مع أصوات شعرية مجايلة ظهرت في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وصعود حساسية جديدة في الشعرية العربية، حيث راحت هذه الحساسية تترجم نفسها حتى في العناوين التي كان شعراء تلك الفترة ينشرون بها دواوينهم. نتحدث هنا، إضافة إلى زكريا محمد، عن أمجد ناصر ومنذر مصري ونوري الجراح وبسام حجار ووليد خازندار … إلخ. وهو ما صار يُدعى منعطف السبعينات، بحسب عدد من النقاد والشعراء.
ما يميز نبرة زكريا محمد أنها نشأت ونمت وتربت في الصمت والتأمل والتفلسف الداخلي. وهذا ما جعلها تنجو من طغيان الغنائية والتفجع العاطفي والتهويمات البلاغية والدرامية.. وحتى الإيديولوجية.
أصدر زكريا محمد خمس مجموعات شعرية حتى الآن، كان آخرها “أحجار البهت” الصادرة حديثاً في رام الله، حيث يعيش الشاعر. وأصدر أيضاً روايتين: “العين المعتمة” و”عصا الراعي”، إضافة إلى مسرحيات وأعمال للأطفال.
“الرأي” التقت زكريا محمد، وكان هذا الحوار حول تجربته الشعرية:
* سمَّيت مجموعتك الأولى “قصائد أخيرة”. هل يمكن القول إنك منذ البداية أظهرت مزاجاً ضَجِراً من الشعر عموماً، ومن الشعر الذي كان يُكتب وقتها؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه لعباً على عنوان مختلف ورغبة في لفت الانتباه؟
– لا، لم يكن أمر لعب على عنوان مختلف فقط. كان العنوان من جهة نكائيا، أي نكاية بأصحاب “قصائد أولى”، ورغبة عميقة بالاختلاف عنهم، بغض النظر عما إذا تحقق هذا الاختلاف في المجموعة أم لا. ثم إنه، من جهة أخرى، كان يحمل “يأس” شاعر شاب من طول الطريق وقلة الزاد. فكيف يمكن إضافة جديد إلى هذا الكم الهائل من الشعرية العربية والأجنبية؟ وكم سيستغرق هذا من زمن؟ لكن فوق هذا وذاك، فالعنوان يطرح السؤال الذي يكاد يكون بلا إجابة: ما جدوى الشعر؟ أي أن فيه شكا في وجود هذه الجدوى. لا يمكن كتابة الشعر من دون حل سؤال الجدوى. يمكن لمراهق أن يكتب الشعر من دون السؤال عن الجدوى. أما الشاعر فملزمٌ بطرحه. وهو سيتصرف لاحقا وفق الإجابة المحددة.
إذن فالعنوان كان يعكس كتلة من الأسئلة الشخصية وغير الشخصية. ولعل ويمكن لعنوان كل مجموعة شعرية معقولة المستوى في مرحلة محددة أن يكون اختصارا لتلك المرحلة. أي انه أنه يمكن قراءة مرحلة بحساسياتها وتناقضاتها انطلاقا من عنوان مجموعة مجموعة، أو من بضعة عناوين لا غير.
* واصلتَ كتابة الشعر، ولكن يبدو أن “لعنة” عنوان باكورتك لاحقتك بطريقة ما، فأنت شاعر مقلّ مقارنة بحال الشعراء. هل الشعر الجيد قليل دوماً كما يُقال؟ أم أن للقلة علاقة بمزاج شخصي في حالتك؟
– الشعر في نظري صرخات متقطعة، مثل صرخات طائر على غصن. لا يستطيع هذا الطائر أن يواصل صرخاته بلا انقطاع. لا بد له من وقفات. لا بد له من مقاطع صمت تسبق الصرخة وتلحقها. من أجل هذا فالصمت جزء أصيل من الشعر ذاته. لا شعر بلا لحظات صمت في عمق القصيدة. وبالنسبة لي لا شعر من دون فترات توقف بين مجموعة من القصائد والمجموعة التي تليها. وفترات التوقف عندي قد تطول حد أن أحس أحيانا أنني فقدت الشعر وصرت غريبا عنه. وقد خبرت مثل هذا الإحساس عند شعراء كثيرين.
هناك بالطبع من أخذ على نفسه أن يكتب الشعر كل يوم. وهذه طريقة أخرى. قصائدي أنا تأتي على شكل دفعات. كأن الأمر يتعلق ببركان يخمد ثم لا يلبث أن ينفجر من دون استئذان مطلقا نفثات من النار والطين.
في كل حال، طرق كتابة الشعر تتعلق بالمزاج الشخصي، وبالقدرة على التنظيم والتركيز.
* يتحدث البعض عن منعطف شعري عربي حدث في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، ويستدلون عليه حتى بعناوين المجموعات الأولى التي أصدرها عدد من شعراء تلك الحقبة: مثلاً: “مشاغل رجل هادئ جداً” لبسام حجار، “مديح لمقهى آخر” لأمجد ناصر، و”الصبي” لنوري الجراح، و”بشر وتواريخ وأمكنة” لمنذر مصري … و”قصائد أخيرة” لك. وهناك أعمال موازية لسركون بولص وعباس بيضون ووليد خازندار وزاهر الغافري …إلخ. هل توافق على أنّ حساسيةً ما أو مزاجاً شعرياً عابراً لجنسيات الشعراء يجمع تلك التجارب؟
– أكاد أوافق على هذا التقييم. كان مزاج جديد يتشكل في نهاية السبعينات. وكان يحاول ان يعلن عن نفسه. والتغيرات الشعرية، أو قل الأجيال الشعرية، تعتلي خشبة المسرح بالمزاج. المزاج، أو ما يسمى الحساسية هذه الأيام، هو المؤشر الأول على حصول التغيرات وعلى ظهور الأجيال الشعرية الجديدة. هذا المزاج يتمثل بطراز ما من الضجر من كلمات معينة، من بدايات معينة للقصائد بجمل محددة، من طول معين للقصيدة. هكذا تبدأ الأمور ثم يتم صياغة هذا المزاج في كلمات لاحقا. كان مزاجي وقتها، كجزء من المزاج الذي كان يتشكل، لا يحتمل مثلا كلمة برتقال أو زيتون في الشعر. لم يكن بإمكان قصيدتي أن تحتمل مثل هاتين الكلمتين. اقتلني إذا أردت لكنني لا أستطيع أن استخدمهما.
علامة كلِّ تغير شعري في رأيي هو الضجر. الضجر من استخدام معين للكلمات. الضجر من إيقاعات معينة. الضجر من موضوعات معينة. وأنا هنا لا أمدح ولا أقدح. ولا أقيم نتاج جيل مفضلا إياه على نتاج جيل سبقه. التقييم مسألة أخرى. فقط أحاول أن أرى كيف يختلف جيل عن جيل، وكيف يغادر مناخاته لا غير.
كذلك كانت قصائدي لا تحتمل الروح البطولية القوية داخل القصيدة. لم يكن أبطال قصائدي بقادرين على ان يكونوا “أبطالا”. كانوا يبدون كما لو أنهم عائدين من الحرب لا ذاهبين إليها. ولعل لهذا علاقة بعنوان مجموعتي “قصائد أخيرة”. وأنا هنا أتحدث عن الشعر لا عن السياسة. هذا تفريق حاسم عندي. هناك أناس كانت لا بطولتهم الشعرية تعكس خيبة سياسية، لا بطولة سياسية. يعني أنها كانت تعكس موقفا سياسيا في الأساس. أو كانت غطاء لموقف سياسي لا يرغب في المواجهة. لا، أنا كان ضجري شعريا لا سياسيا. كان محاولة للافتراق عن السائد.
* استطراداً، تبدو تجربتك عربية بموازاة كونها فلسطينية. إنها – على الأقل – تتجاوز هويتها الفلسطينية البديهية. لا يجد القارئ في شعرك ما يتوقع وجوده في مطلق شعر فلسطيني. ما رأيك؟
– لا أدري إن كنت أوافق هذا أم أخالفه حقا. تجربتي الشعرية في جزء رئيسي منها كانت محكومة بالابتعاد عن محمود درويش وعن عوالمه. كان لدي رغبة ساحقة بأن لا أسير في الطرق التي سار فيها. لذا لا بد أنني بحثت عن أسانيد شعرية عربية كي أتمكن من ذلك. بهذا المعنى فقط يمكن لك أن تقول أن تجربتي “عربية”. أعني أنني افترقت عن الصورة الفلسطينية لشعر الستينات والسبعينات. أما الآن فكل الشعر الفلسطيني تقريبا ليس فلسطينيا إذا أردت ان تحاكمه من منطلق شعر السبعينات. وحتى دواوين محمود الأخيرة يمكن إدراجها في هذا السياق.
كان تأثير محمود درويش علي كبيرا جدا. لقد أرغمني على ان أبحث عن طرق أخرى. هو احتل الطريق برصيفيه، فكنت مرغما على أن أبحث عن دروب جديدة. يعني: تأثير بالسلب لا بالإيجاب. لكنه لا يقل قوةً وحدّةً عن التأثير الإيجابي. مع ملاحظة أن تعبيري السلب والإيجاب هنا بمعنى التعاكس، ولا تحملان معنى القدح أو المدح. وبمعنى آخر، لا يمكن قراءة تجربتي الشعرية من دون العلاقة مع تجربة محمود درويش.
كنت أستصلح أرضا وعرة في التلال، لأن درويش احتل الأرض الصالحة للزراعة كلها. وكان على الشعراء الفلسطينيين أن يعملوا فلاحين عنده، أو أن يذهبوا إلى الأرض البور للبحث عن بقعة خاصة بهم واستصلاحها والعيش على ما تنتجه. أنا ذهبت إلى هناك، إلى الأرض البور. لقد أرغمني محمود على الذهاب على هناك. عليه، لذا فله فضل في كل حبة بندورة حمراء قطفتها في التلال الوعرة. أنا أحفظ له هذا الفضل.
من ناحية ثانية، كان لدي إدراك دوما بأن عليّ أن لا أسمح لإسرائيل ودباباتها بإملاء جدول أعمالي الشعري. لقد أسقطت وجود الإسرائيليين من قصائدي. لا أستطيع ان أحرر الأرض منهم. لكنني أستطيع ان أحرر قصيدتي منهم. أستطيع ان أمنعهم من الدخول إلى قصيدتي. وقد فعلت. لكن، علي أن اعترف، أن ظلالهم تملأ قصائدي، وأن العنف الذي يملؤها هو انعكاس لعنفهم. أنت تستطيع أن تطرد إبليس، لكنه سيعزف لك على مزماره تحت النافذة.
* قلت في شهادة عن تجربتك الشعرية إنك امتلكت صوتك الخاص اعتباراً من مجموعتك الثالثة “الجواد يجتاز أسكدار”، وأن ذلك كشف لك “جدوى الشعر”. أريد أن أسألك ما هي جدوى الشعر فعلاً. لماذا نكتب الشعر؟ وهل نحمِّله وظائف وأدواراً فوق طاقته؟
– نعم، في تلك المجموعة ملكت ما يمكن أن أسميه صوتي، رغم إبهام هذا التعبير. من وقتها شعرت أنني صرت حرا، وأنني قادر على ان أقول ما أريد وبالشكل الذي أريد. لم تعد قصيدتي تكتب من أجل أحد. صارت تكتب من اجل متعتي أساسا. ثم هي صارت تميل للبساطة والوضوح على عكس السائد. وهو سائد حتى الآن. وفي هذا السائد تكون البساطة والوضوح عيباً. يجب أن تلفَّ القصيدة وتدور حتى تبدو معقدة، لأن البساطة والوضوح عيب. أنا قبلت العيب، مشيت فيه. وعلي ان اعترف أن لدي رغبة عميقة في المعاكسة. رغبة هائلة.
في كل حال، نشرت في تلك المجموعة بروفات قصائدي. كما نشرت قصيدة مع مختصراتها. وكان هذا يعني أن القصيدة يمكن أن تقلَّم حتى لا يتبقى منها سوى جملة واحدة. كان يعني أن الشعر ليس هو بل هو التقليم والحذف. لا يصبح الشعر شعرا بالكتابة بل بالحذف، أي بمنع الكتابة وتقييدها. الشعر في الجوهر كبت للكلام، كبت للكتابة، لا إطلاق لحريتهما على مداها. وكان هذا يعني أن القصيدة يمكن ان تلغى في النهاية لنصل إلى الصمت.
* تبدو قصيدتك وكأنها ابنة بارَّة للعزلة والصمت والكثافة والخفوت. رغم ذلك كتبتَ روايتين. هل لديك هاجس أن تكون روائياً بالقدر الذي أنت محسوب فيه كشاعر؟ هل هي رغبة في الإفلات من شروط قصيدتك إلى نص قائم على السرد والاستطراد؟ وهل يمكن أن يكون الشعر عائقاً وطريقة للقول في آنٍ واحد؟
– ليس لدي هاجس ان أكون روائيا. ليس لدي حتى هاجس أن أكون شاعرا. أنا أمتع نفسي بالشعر، وبأشياء أخرى. أحاول ان أوسع حدودي فقط. أنا إنسان أولا. وأريد أن أوسع حدودي كإنسان فقط. ولو كان لدي الوقت الكافي لفعلت أشياء كثيرة جدا غير الشعر والكتابة. لكن الوقت عدوي. وضمن هذا الوقت المحدود أحاول ان أمد حدودي.
بخصوص الرواية، أنا أوافق على تقييمك. فقد كانت قصيدتي تأكل نفسها دوما، وتقلم ذاتها، وتقترب من الانمحاء. وكنت أريد عبر تجربة الرواية أن أمارس العكس. كنت أريد ان أرى كيف تتطاول الكتابة حتى يصبح ثرثرة. وقد جربت ذلك عبر كتابة روايتين. يعني كان اختصار قصيدتي المؤلم يدفعني إلى عدائها وعداء الشعر بالطريقة التي تكتبه فيها يدي. يعني: ربما كنت كتبت الرواية نكاية بالشعر. لكن لعل مشكلة الشعراء مع النصوص النثرية مثل مشكلة كومبارس يصعد على الخشبة كي يقول جملة واحدة. هذه الجملة ضرورية للمسرحية كلها. لكن الكومبارس يظن أن حصته غير عادلة، لذا فهو حين يعود للبيت يعيد صياغة دوره أمام زوجته، ويحول الجملة إلى عشر صفحات. لعل الأمر هكذا!
* هناك نبرة فلسفية واضحة ومحبّبة في تجربتك. الشعر عندك ليس لغة وممارسات لغوية فقط. لعل هذا إحدى سمات شعرك القائم على الاقتصاد والتأمل والصمت. هل يمكن القول إن هذا السلوك الشعري يحمل ازدراءً غير مباشر بما يسود من تهويم لغوي وبلاغة تقليدية في الكثير مما كُتب ولا يزال يُكتب من شعر عربي؟
– أظن أنه يكون أمام الشاعر في البدء طرق عدة كي يسير فيها. وربما كانت طرقا أربعة: طريق الاندفاع مع الإيقاع، وطريق السير مع اللغة، وطريق التهويم مع المشاعر من حزن أو فرح أو حب، وطريق الفكرة. محمود درويش مثلا تدفق مع إيقاعه. قصيدته من دون إيقاعها تفقد نفسها. لذا يظلم حين يترجم. آخرون تدفقوا بالعاطفة، وغيرهم ساروا مع اللغة. وعند لحظة محددة عليك أن تحسم طريقك. طبعا هذا لا يعني أنك تتخلى عن الأشياء الأخرى. لا، الشعر هو كل هذه الأشياء معا. لكن تركيزك يجب أن يكون على شيء واحد. لا تستطيع أن تظل مترددا مثل حمار بوريدان بين مخلاتين. عليك ان ترمّ التبن من مخلاة محددة. أنا اخترت الفكرة. يعني أن تأملا ما يخترق قصيدتي. والتأمل من دون الصمت غير ممكن. عليه، فالصمت موجود في قصيدتي بالضرورة، انطلاقا من الطريق الذي اخترته.
فوق ذلك، اعتبر نفسي تلميذ أبي العلاء. وقد حاول الشاعر الضرير أن يخلص الشعر من مثيراته ومهيجاته. وقد بدا له في لحظة من اللحظات أن في هذا هجران للشعر. يقول: “وقد كنت قلت في كلامٍ قديم إني رفضت الشعر رفض السَّقْبِ غرْسَه والرأل تريكته”. لكنه عاد ليكتشف أنا ما أراده هو أن يترك مهيجات الشعر. فهم، كما يقول: “زيّنوا ما نظموه بالغزل وصفة النساء ونعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمر، وتسببوا إلى الجزالة بذكر الحرب. واحتلبوا أخلاف الفكَر، وهم أهل مقام وخفض في معنى ما يدعون أنهم يعانون من حثّ الركائب وقطع المفاوز ومراس الشقاء”. هذا هو ما رفضه أبو العلاء. كان يريد لشرارة الشعر أن تنقدح دون كل هذا الزبد. وكان يجرب ليصل إلى هذا، ولا شيء بين يديه سوى اللغة ومأساة الإنسان في الكون. من قدحهما معاً كان يريد للشعر أن يأتي. ولعلني أردت ان أفعل مثله. أي ان تكون فكرة بلا مهيجات هي مدار قصيدتي.
* مع صدور مجموعتك الجديدة – الخامسة: “أحجار البهت”، كيف تصف علاقتك بالشعر. ما الذي تخليت عنه وما الذي اكتسبته؟
– علاقة احترام متبادل. أنا أعمل عنده وهو سيدي. لكن على كل واحد أن يضبط نفسه وأن يحترم حدوده حتى لا تنفجر هذه العلاقة.
أما بشأن الخسارة والربح انطلاقا من المجموعة الأخيرة، فلست واثقا من الإجابة. لا بد أن يمضي وقت كي أقيم عملي فيها، مقارنة بما فعلت سابفا.
أما بخصوص الشعر والشعراء، فقد تخليت عن نصيبي من قطعة الأرض التي يقتتل عليها الشعراء. ليس لدي أي رغبة في منافسة زملائي الشعراء على شيء. لدي أشياء تحيرني وتبهتني، وأنا مشغول بها تماما عن كل شيء. من أجل هذا ربما سميت المجموعة باسم “أحجار البهت”. أشياء صغيرة جدا أجعل قصائدي تدور حولها، وأشياء تتعلق بالميثولوجيا. هذه الأشياء تبقيني في بيتي. سألني شخص ما قبل أشهر: “وينك يا رجل؟ إنت موش في البلد؟ بطلنا نشوفك!”. رددت عليه: “اسمع، كل يوم الصبح بوقّف تاكسي، بطلع فيه، وبقول للسائق: على مكة قبل الإسلام”!
أنا في الواقع من عدة سنوات موش عايش في رام الله. أنا عايش في مكة قبل الإسلام!. وقد أثمرت هذه الإقامة في مكة الجاهلية عن كتاب طبع أخيرا بعنوان: “عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية”.
الرأي



