بول شاوول متحدثاً عن حياته والمدينة والمقهى والعزلة والمسرح والشعر
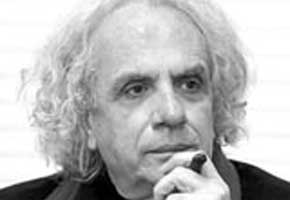
التجريب إماتةٌ للموت وأنا أحلم بقصيدة لا تبدأ ولا تنتهي فيها جنون وفوضى ولامحدودية
السيجارة وفيّة ولم تغادرني يوماً أفلا تستأهل أن أكتب كتاباً عنها!
كنا أمام خيارين، إما أن نجالسه في المقهى حيث يجلس كل يوم بعد الساعة العاشرة ليلاً، وإما أن نزوره في منزله المستقر على سطح بناية في الحمراء. فضّلنا أن يكون اللقاء في المنزل، في خضمّ الحياة التي يعيشها بول شاوول، مع كتبه التي يختنق بها البيت، والأثاث الذي يشبهه كثيراً. قررنا أن “نهجم” عليه في بيته لا أن نلتقي في منطقة قد يحسبها هو محايدة كالمقهى، فيما هي منطقته التي لا يمكن هزيمته فيها. في تلك الليلة الباردة استقبلنا بدفء. سيجارته تتدلى من فمه كما الثريا من السقف. ابتسامته أيضاً عالقة بين شفتيه مع السيجارة. ذهبنا إلى الشاعر الكبير لنقرأه في كتابيه الصادرين حديثاً “بلا أثر يذكر” و”دفتر سيجارة” وقصيدته عن أطفال غزة (دار النهضة العربية)، وكتابيه اللذين يصدران تباعاً هذه السنة (“حديقة المنفى العالي”، و”حجرة مليئة بالصمت”) لنحتفي بالشعر أولاً، وبعلاقته بالأشياء والناس، بالحب والموت والألم والعدم وسواها. وعن كل هذه الأمور كان هذا الحديث.
* لنبدأ من الولادة، أين كانت، وماذا تتذكر من تلك الحقبة؟
– ولدت في سن الفيل. كنا عشرة أشخاص: ثمانية أولاد وأب وأم. عائلة غير ميسورة لكن ليست فقيرة. أبي كان شرطياً، ولم يكن حرامياً. كانت كفّه نظيفة وهذا مهم جداً. أمي كانت مؤمنة. أبي لا أتذكره يدخل إلى الكنيسة إلا في مناسبات الدفن، حتى أنه لم يكن يذهب إلى الأعراس، ولا علاقة للأمر بالإيمان. أمي كانت مؤمنة جداً، وأتذكرها تضع حصى مسننة تحت قدميها وتصلي للعذراء وتبكي. كانت تصلّي لي في الإمتحانات، ولمرتين أو ثلاث مرات صلّت لي ورسبت. رجوتها أن لا تصلّي لي في الإمتحانات، لأن صلاتها بدت لي السبب في رسوبي.
في تلك الأيام كانت سن الفيل غابة صنوبر، كانت قطعة خضراء من الصنوبر.
* عندما قلت إن أباك شرطيّ ذكّرتنا بالرحابنة…
– أبي كان معهم. كان يعرفهم جيداً وكان يخبرني أنهم كانوا يحررون محاضر ضبط في النهار، وفي الليل يعزفون في مكان ما. كان أبي شرطياً لكن لا علاقة له بالعسكر. لم يمارس القمع قط. أنا بدأت أشعر بحريتي منذ سن الثانية عشرة.
* لم تكن ثمة سلطة؟
* كانت ثمة سلطة لكن مموّهة وبالمواربة. عندما وضعني أهلي في الصنايع، وكنت في العاشرة من عمري بعد نيلي السرتيفيكا، لكي أتعلم مهنة، اشتريا لي ثياب الصنايع، ثياب الشغيلة، المريول، وكانت الصنايع حيث الحديقة اليوم، وكنت امشي من سن الفيل إلى النهر في برج حمود، إلى البرج، ومن ثم إلى رأس بيروت بالترامواي.
تعلمتُ النجارة والحدادة أولاً
* ماذا تعلمت؟
– تعلمت في البداية نجارة وحدادة وتفصيل برادي. في أول شهرين حرقت أصابعي ويديّ، لم أنفع في الصنايع، صرت أهرب من المدرسة، هربت لثلاثة أشهر. كنت أهرب إلى مار روكز، إلى أحراج الدكوانة. رجعت ذات يوم وكان أبي ينتظرني، وكانت أفضل لحظة في حياتي. سألني: أين كنت؟ قلت: في المدرسة. ردّ عليّ: وهذا المكتوب ماذا يعني؟ كانت مدرسة الصنايع قد بعثت إليه برسالة تعلمه بتغيّبي منذ أشهر عن الصفوف. غضب وراح يصرخ، فأتت أمي وطلبت إليه أن يتركني وشأني لأنني لست مسروراً في الصنايع. ثم أخذني أخي إلى مدرسة الـ”سان جان لا بوتر” في الدكوانة.
* كم ولداً كنتم في البيت؟
– كنا ثمانية. أنا الصغير وأخي التوأم جورج. في تلك الأيام كانوا يتزوجون مبكراً. في عمر الخامسة والثلاثين كان أبي جداً. الفارق بيني وبين ابنة أختي ثمانية أشهر فقط. كانت أياماً جميلة. تعلمت في المعارف أي المدرسة الرسمية في سن الفيل، لأن أوضاعنا الإقتصادية لم تكن تسمح لنا بالتعلم في المدارس الخاصة. في المدرسة الرسمية كان معلم الفرنسية يدرّسنا الفرنسية بالعربية لأنه لم يكن يعرف “فرنساوي”. عندما ذهبت إلى المدرسة بعد الصنايع، أجروا لي فحصاً باللغة الفرنسية وكانت نتيجته صفراً.
* من أين أتت الفرنسية إليك، وأنت الضليع في اللغة الفرنسية وترجمتَ منها مئات القصائد والمسرحيات؟
– هذا أمر مهم كثيراً، وأتحدث به دائماً إلى الكتّاب والشعراء الشباب. في العاشرة من عمري بدأت أكتب بعض الخواطر التي لم تكن ذات أهمية، أو قيمة، لكنها كانت تدلّ إلى اهتماماتي الأخرى. في المدرسة انتبهت إلى أنني لا أعرف كلمتين في الفرنسية. الأبونا قال لي إنك لا تعرف الفرنسية، بعد سنة، وبعد التلكّؤ، ذهبت واشتريت “أنا كارينينا” لتولستوي وكنت في الثانية عشرة من عمري، واشتريت قاموساً واحضرت دفتراً جعلته قاموسي الخاص، وبدأت بالترجمة. كنت أقرأ الصفحة لأيام حتى أتوصل إلى فهمها. الترجمة جعلتني أقرأ أكثر. في صف الثالث متوسط كان استاذ الفرنسية نفسه يعلّمنا منذ مجيئي إلى المدرسة. حمل موضوعي الإنشاء وعرضه على زملائي، ونوّه بتطور لغتي الفرنسية اللافت. الترجمة جعلتي اقرأ أكثر. يومذاك كانت ساحة البرج مقصدنا، كان أبي يعطينا ليرة نهار الأحد، وكنت أبيع قناني العرق الفارغة أجمعها من دكان جدي، وكان ثقيل الدم. كنت أشتري بليرتين الكثير من الكتب والمجلات، وتعرفت إلى المكتبة الوطنية في البرج، مكان مجلس النواب حالياً، كان المسؤول هناك عبد اللطيف شرارة، والد وضاح شرارة. كان شخصاً أسمر اللون ولطيفاً. كنت أذهب في الصيف، تحضّر لي أمي سندوياً من الصعتر، طعام الفقراء في حينه، وكانوا يقنعوننا بأن الصعتر يفتّح الذهن، مع أنه كان كلما أكلته “يبلّط” عقلي ويصيبني بالنعاس. ومن طعام الفقراء أيضاً كنا نأكل عرائس السكّر مع الزيت، البندورة مع الزيت، وكانت أطيب أكلة أتذكرها. كنت أنزل إلى المكتبة الوطنية في الساعة العاشرة وأعود في الساعة الثانية بعد الظهر. كانت مكتبة رائعة، سرقتها الميليشيات. هناك قرأت الكثير من الكتب. قرأت “قدموس”، الكتاب الأهم لسعيد عقل. قرأت “بنت يفتاح” الذي كان مقطوعاً من السوق في حينه. كنت أحب جبران خليل جبران أيضاً. تربّيت على سعيد عقل والياس أبي شبكة وصلاح لبكي، وأمين نخلة الشاعر الكبير الذي أتمنى أن يقرأه الشعراء اليوم. هؤلاء مدرسة في اللغة والشعر والنبل الشعري. قرأت بول كلوديل، وبدأت بالتعرف إلى بول فاليري. قرأت طه حسين في “حديث الأربعاء” و”المعذبون في الأرض”. تملكت لغة وصرت أقرأ وأكتب باللغة الفرنسية. هذا أهم ما فعلته في حياتي.
… ثم كتبتُ الشعر العمودي في “الحكمة”
* كنتَ تتابع دراستك في تلك الفترة؟
– طبعاً، وكنت أكتب شعراً عمودياً في تلك الفترة. ونشرت في سن الخامسة عشرة قصيدتين عموديتين في مجلة “الحكمة”. أرسلتهما بالبريد. كان جميل جبر مسؤولاً. إحدى القصيدتين عن جدّي عنوانها “مناجاة عجوز” وكان جدي ثقيل الدم كما أخبرتكما، والثانية عنوانها “أوراق الخريف”. وإذا بإسمي يظهر على غلاف المجلة، والقصيدتان منشورتان في داخلها وكان ذلك في عامي 1959 و1960.
* كانت تلك المرة الأولى ترى فيها اسمك مطبوعاً؟
– صحيح، يومذاك فرحت كثيراً جداً، نزلت إلى البرج واشتريت عدداً من مكتبة قرب سينما روكسي هناك.
* هل تابعتَ حياتك على هذه الوتيرة؟ أعني هل تابعت القراءة والترجمة والكتابة؟
– نعم، لكن مراهقتي لم تكن مثالية بالمعنى الشائع. كانت مراهقتي غريبة وجميلة. مثلاً في سن الرابعة عشرة بدأتُ التدخين، وبدأت أشرب العرق والويسكي. كنت عبثياً بالمعنى العميق للكلمة، صحيح أنني كنت أدرس وأقرأ، لكني كنت أسهر كل يوم، كنا نشتري علبة سردين ورأسَي بندورة وبطحة عرق ونذهب إلى الحرج في سن الفيل ونسكر هناك. تفتحتُ على الحياة مبكراً.
* هل تتذكر المرأة الأولى في تلك السن؟
– نعم، كانت يونانية، اسمها ايفدو. كانت جميلة. بعد عشرين سنة، وكنت قد صرت معروفاً نسبياً، قرأت حواراً معي في المجلة عند الحلاق، وقرأت اسمها في المقابلة بصفتها أول امرأة أحببتها، ففتشت عن رقمي، واتصلت بي، وأعطتني موعداً في مكان لم استطع تحديده. ضعت وأضعتها ولم أجدها ولم التق بها ثانية. ثم كانت تجربتي الجنسية الأولى في سن الرابعة عشرة في سوق المتنبي، أو سوق البغاء كما كان يسمّى، وكان قريباً من ساحة البرج، وسأكتب يوماً ما عن هذا السوق. أحفظه غيباً. كنت أرافق اصدقائي، منهم من كان يحمل سكيناً أو موسى أو خنجراً. كنت أجمع ليرتين كل فترة وأقصد السوق. بليرتين كنا نحصل على امرأة غير صغيرة. كنت أمارس الجنس مع امرأة أكبر من أمي اسمها ام عدنان. لا يمكنني أن انسى هذه المرأة العظيمة. كانت تقول لي: “على مهلك يا ابني”. يا ابني!!
* لديك احترام كبير للبغاء والعاهرات…
– طبعاً طبعاً، هن نساء قصيدة “نساء” في كتابي “كشهر طويل من العشق”.
* هل كانت منتهية تلك المرأة، على شاكلة قصيدة “نساء” في “كشهر طويل من العشق”؟ أعني أمّ عدنان تلك؟
– بالتأكيد، بليرة ونصف أقول لك، بهذا المبلغ لا يمكن أن تحصل إلا على امرأة منتهية. في احدى المرات، التقيت بأستاذي في المدرسة، وكنت في احد الصفوف التكميلية، هناك في السوق. وبدلاً من أن يؤنبني، أدخلني معه إلى مكان أرقى مرتبة من الذي كنت معتاداً على ارتياده ويسمى غرفة “آنغاجيه” ENGAGEE. الرائحة لا تفارق أنفي. أتذكرها رغم مرور عشرات السنين. رائحة الدخان والمني واللهاث والخمر. كانت أشهر امرأة في السوق، وكانت تديره مع نساء عديدات، اسمها ماريكا. صارت مضرب مثل في لبنان. وكانت غالية الثمن لا نستطيع الوصول إليها.
* ألّفوا أغنية على اسمها.
– نعم، لحنوا لها أغنية، كنا نذهب نحن والشباب ونتفقد السوق علّنا نحظى بشرف رؤيتها. كانت نظيفة جداً. كان سوق البغاء في لبنان مشروعاً حضارياً، لكن عندما جاءت الميليشيات والوحوش من الريف وريّفوا المدينة، مع المعتقدات الدينية الزائفة والمحرمات، كسّروا البرج ودمّروه وراح كل شيء. يومذاك كانت بيروت الحقيقية، وليست بيروت الميليشيات. كانت بيروت الحرية، المرأة كانت حرة. المجتمع كان في مرحلة خروج، اليوم عاد إلى حيث خرج. وكان هناك الكثير من المقاهي في بيروت. وهي أمكنة غاية في الأهمية. أنا تربيت في المقاهي. كان هناك مقهى “برازيليا” في سن الفيل، ولا يزال صامداً حتى اليوم، فيه نجحت في البكالوريا والفلسفة، وكان هناك مقاهي البرج: “لاروندا”، “الأوتوماتيك”، “قهوة القزاز”، و”الحاج داوود” على المنارة.
* ما هي المقاهي التي شهدت إقفالها في حياتك؟
– “الشاليه سويس” في الجديدة، لا أعرف إذا كان لا يزال موجوداً. “برازيليا” لا يزال مكانه. كل مقاهي البرج ذهبت إلى الإقفال. وكانت هناك سلسلة من المقاهي في باب ادريس، هذا كان من أجمل الشوارع في العالم. “الأوتوماتيك” اقفل، كان ثلاث طبقات، الطبقة السفلى كانت مخصصة للغرام، كانت هناك بركة. عندما بدأت الحمراء بالظهور، بدأت تموت مقاهي البرج.
* متى كانت المرة الأولى ارتدت فيها المسرح؟
– مثلتُ مسرحيتين في المدرسة. إحداهما مسرحية عن السموأل، كتبها اليازجي، كان لي دور الصبي شريح، الإبن الذي اختطف. قرأت الكثير من المسرحيات، بدأت بسعيد عقل وأحمد شوقي، وقرأت آنوي وكامو وسارتر، وكل من كتب مسرحا في الفرنسية.
* مراهقتك كانت لطيفة كما يبدو، لأنك لم تعش حروباً في صغرك…
– بلى، عشت حرب عام 1958، كنت صغيراً. نحن تربّينا في الحروب، وكبرنا في الحروب، طولنا في الحروب، وقصرنا في الحروب.
… ثم كانت الجامعة
* ماذا بعد المراهقة؟
– المرحلة الأهم في حياتي هي مرحلة الجامعة، في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. كانت جامعة حقيقية وليست كهذه الموجودة اليوم. يجب أن يقفلوها هذه الجامعة المنقسمة اليوم فروعاً وطوائف. كانت مرحلة نضالية. علّمتني الجامعة كل شيء. لم أكن مسيساً، كنت أحمل كل إرث الضيعة: العائلية والمناطقية والتخلف… كل الإرث.
* وكيف تخلصت من هذا الإرث الثقيل؟
– في الجامعة أسسنا حركة الوعي. بدأت هذه الحركة ضد اليسار. كنا نلتقي مع اليمين المسيحي والمسلم المحافظ. كنا ننزل في لوائح مشتركة في الجامعة. لا يمكن أن تأتي من بيئة محافظة وتجذب أناساً محافظين بمعجم يساري. في وقت لاحق انفصلنا عن الكتائب والأحرار.
* كان هذا مقتلكم؟
– لا لا، انفصلنا لكننا كنا نخوض الإنتخابات في لوائح مشتركة. انشققنا، وصرنا “جبهة الشباب اللبناني – حركة الوعي اللبنانية”. قمنا بأهم إنجاز، وهو تأسيس “اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية”، الذي ساهم في تأسيسه الكثير من الأطراف من الشيوعيين ومنظمة العمل الشيوعية والقوميين والأحرار والكتائب والكتلة الوطنية. كانت لنا إنجازات كبيرة. تظاهرات بعشرات الآلاف، تعرضنا للضرب كثيراً على أيدي الشرطة والأمن. كل مختبر في الجامعة كنا نحصل عليه بإضراب أو اعتصام أو تظاهرة. في أوائل السبعينات، احتللتا الجامعة، وطردنا العمداء والموظفين، وعيّنا عمداء من قبلنا بتسيير ذاتي، وأنا كنت عميد كلية التربية.
* هل تعتقد بضرورة أن يحتل الطلاب اليوم الجامعة اللبنانية؟
– يجب أن يلغوها. يجب أن يطردوا كل الطائفيين منها، لكن من سيقوم بهذه المهمة طائفي أيضاً. هذه الجامعة اللبنانية كانت هي نبع لبنان، منها تخرج معظم الشعراء والأدباء والكتاب المعروفين اليوم. هي خزّان. الخران مسموم اليوم. الطوائف سمّمته. هذه هي الحرب الأهلية. الطلاب جاهزون لحرب أهلية، مدججون بالطائفية والتعصب. يقال إن ثمة اساتذة يعلّمون في الجامعة وشهاداتهم مزوّرة، وطلاباً ينجحون بالقوة، وأساتذة طائفيين، ويقال إن ثمة اساتذة ادب عربي يعلّمون بالعامية لأنهم لا يعرفون الفصحى، وهناك اساتذة مسرح لم يشاهدوا مسرحية واحدة في حياتهم. هؤلاء الذين خربوا البلد وقتّلوا الناس، لا يزالون حاضرين، وهم يهيمنون على الجامعات. أنا أتحدث بألم عن الجامعة. كانت حلمنا. علّمتني السياسة والحياة وكل شيء، مهما فعلت لا أكافئ هذه الجامعة. لولاها لكنت انتسبت إلى إحدى الميليشيات. أعطتني الجامعة اللبنانية مناعة ضد الدخول في الحرب. بعد اندلاع الحرب الأهلية، وتقسيم الجامعة، عقدنا مؤتمراً صحافياً في “حركة الوعي”، وعلّقنا نشاط الحركة السياسي. لم نلوّث أيدينا في الحركة، لا بالمال ولا بالدم. علمنا أنها ليست حربنا، ولهذا كنت ضد الجميع، واصطدمت بأحزاب الطائفة، وخُطفت، وهربت إلى الحمرا، إلى هذا البيت، ثم (النائب) ميشال عون اصاب بيتي بقذائف عدة في قصفه العشوائي أثناء “حرب التحرير” المزعومة، وأحرق ثمانمئة كتاب، كل كتاب يساوي رقبته. كنت قبل الحرب، في فترة الجامعة، اعيش حياة جماعية مع الأصدقاء والرفاق. أتت الحرب، وانقطعت.
العزلة والبيت والمقهى
* هل نفهم أن عزلتك كانت قسرية؟
– عندما أقول عزلة، لا يعني ذلك أنني اعيش في برج عاجي. أنا اليوم، إلى حد كبير معزول، لكنني أعيش كل تفاصيل البلد ومشكلاته، وأتابع، وأكتب مقالات سياسية يومية، خارجة من الحدث وليس مجرد تنظير فحسب. لا أؤمن بالوسط. لا شيء عندي وسطي. لا في الحركة ولا في الحرب ولا في الثقافة ولا في الشعر ولا في العلاقات أو المسرح. لا شيء وسطياً. من هنا يتضايق مني بعض الناس. معهم حق. أحياناً أحمل السلّم بالعرض. ابتعدت عن الأجواء الثقافية والعلاقات والتزلف والعداوات، لكني بقيت في قلب الثقافة. ابتعدت عما يسمّى بالعلاقات.
* لك علاقة مميزة بالمقاهي…
– المقهى هو نافذة المدينة. عندما لا تكون المقاهي موجودة، تنغلق المدينة. المقاهي هي الحوار وقبول الآخر. المقاهي في المدينة لا تسألك عن أصلك وفصلك. في الحروب تقفل المقاهي، والمدينة. الأنظمة العربية ريّفت المدن العربية. الميليشيات ريّفت المدينة ولا تزال تريّفها…
*… إذا بقي هناك ما تريّفه.
– لا يزال هناك أشياء مدنية. ما دمنا موجودين يعني أن هناك أشياء مدنية. وهذا الهامش لم يستطع أحد أن يقضي عليه. كل الذين دخلوا إلى بيروت لم يستطيعوا أن يقضوا على هذا الهامش. هذه المدينة عاشت أكثر من عشرين حربا ولا تزال صامدة. كل من دخل إلى بيروت لتدميرها وتشويه صورتها وضرب تنوّعها هو إسرائيلي وصهيوني، ربما من دون أن يدري.
* على المستوى اليومي، على مستوى بول شاوول الإنسان، كيف يمكن شخصاً أن يبقى لفترة طويلة بهذا التماسك الشعري والفكري وهو وحده؟
– أنا وحدي، ولكن داخل المجتمع. عزلتي هي ضد الأمراض الإجتماعية والطائفية. يجب أن نحمي انفسنا من أعراض المجتمع وليس من المجتمع. عزلتي تموّه العلاقة العميقة مع جذور المجتمع. العزلة لا تعني الإنفصال، بل الإتصال العميق بالأمور والتناقضات. أنا أؤمن بالصداقات وأؤمن بالحب مع المرأة.
* لكن في لحظة الكتابة، ألا تحتاج إلى عزلة؟ ألا تفرضها على الآخرين عند الكتابة؟
– هذه العادة أخذناها من باريس. أنا لم أكتب الشعر في المقهى، بل أنقّح شعري. أكتب الشعر في البيت. ثم انني لا استطيع أن أقرأ اقل من أربع أو خمس ساعات يومياً. لهذا لا استطيع أن أضيّع وقتي في جلسات المزاح في المقهى، مع احترامي للجميع. الناس يتحدثون في المقهى ليريحوا انفسهم من الهموم. أنا أريح نفسي بالقراءة والكتابة.
* دخل المقهى كمادة في نصوصك، كبطل مسرحي؟
– البيت أيضاً. في النهاية المكان هو الأفكار. المقهى فكرة، والبيت فكرة أو مجموعة أفكار ومشاعر. أنا مقصّر في أمرين. أحلم في الكتابة عن المقهى كما كتبت عن السيجارة، ولكن أحتاج إلى الهدوء، كما أحلم بالكتابة عن الطاولات والكراسي. أنا آخر من يترك المقهى كل مساء. أصادق “الغارسونيي” كما تعرف. يخبرونني عن مشاكلهم وهمومهم. كنت أكتب لهم مكاتيب غرامية. يطلبون إليّ أن أكتب لهم رسائل يرسلونها إلى من يحبون. المقهى صار من عادات جسمي. من عادات أفكاري ويديّ وحواسي وبصري. لا أعتبرها تفاصيل.
* الموضوع لديك ليس غاية، مثلاً أن تكتب كتاباً عن السيجارة، فبالتأكيد ليست السيجارة غايتك، لكن الكتاب يذهب بنا إلى حياتك…
– هذا صحيح، ولكن لا تنس… أنا أكرّم السيجارة. وهذا مشروعي. وليست هي وسيلة فقط لأصل إلى مكان آخر. هذه السيجارة وفية ولم تغادرني يوماً. اهلي وأصدقائي ماتوا، بيتي غادرني والزمن غادرني. نجحت في المدرسة مع السيجارة. أحببتُ وكانت في يدي. انخطفتُ وكانت في يدي. تظاهرتُ وهي في يدي. لم تغادر السيجارة يدي منذ خمسين سنة. في احدى المرات كنت ادخن في السرير وغفوت قليلاً وكاد بيتي أن يحترق. السيجارة عالقة في فمي. ألا تستأهل أن أكتب كتاباً عنها؟
هي مغرمة بي
* لكن أليس العكس صحيحاً، بمعنى أنك أنت متمسك بها أيضاً؟ لو قررت التخلي عنها لتركتها.
– هي لعبة متبادلة. أنا وفيّ لها. هي مغرمة بي. في الكتاب عاملتُها كامرأة.
* متى تشعرك السيجارة بالحزن؟
– لا تشعرني بالحزن. فيها فكرة الزوال. الزوال على مراحل. الجسم مثل السيجارة ينقص ويتأكل.
* في الكتاب يظهر أن لدى السيجارة قدرة على العود الأبدي النيتشوي، عندما تصفّ سجائرك أمامك على الطاولة ولا تعرف أيها تختار. لديها قدرة على محاربة العدم. ألا تغار منها؟
– صحيح، ولكن السيجارة اليوم يبدو كأن زمنها ينتهي في العالم. السيجارة كانت حضارة متفشية في كل العالم. كانت الأمنية الأخيرة للمحكومين بالإعدام وللكثير ممن يحتضرون. أمي كانت تحتضر، أشارت لي بيدها أنها تريد سيجارة، لأنها كانت عاجزة عن الكلام. أعطيتها سيجارة ووضعتها في فمها، ومن دون أن أشعلها أخذتها وابتسمت ابتسامة الوداع. السيجارة لغز كبير جداً. العمال لديهم سجائرهم، والطبقات الإجتماعية، ولدى ممثلي السينما. السيجارة رمز الرجولة عند الرجال ورمز القوة لدى المرأة. ثمة فيلم مصري عنوانه “الدنيا سيجارة وكاس”. السيجارة إلى انقراض. يمارسون على المدخنين الإرهاب بحجة أن السيجارة تتسبب بالسرطان، وهم يلوّثون العالم بالمصانع والأسلحة والحروب. يحمّلون السيجارة مسؤولية كل مآثم في العالم.
* تقنياً، كيف استطعت أن تجترح كتاباً من فكرة واحدة؟
– لا أعرف. طبعاً هذا يحتاج إلى قدرة. لم يجرؤ أحد على الخوض في هذا الموضوع. إنها مجازفة كبيرة. عندما بدأتها لم أكن أكيداً من أنني سأكملها. لكنها ورّطتني، لأنها متجذرة فيّ، هي سيرتي الشخصية. هي كائن حميم. لا أزال حتى اليوم، أفتتح صباحي بالسيجارة. أدخن سيجارة واحدة، سيجارة “غولواز” (يفتح علبة خشبية ويرينا علبة “الغولواز” في داخلها) تشبه كثيراً غلاف كتابي. الكتاب يشبه علبة سجائر. الموضوع صعب. أن أكتب كتاباً عن السيجارة فهذا أمر ليس ككتابة “بلا أثر يذكر”. صحيح أنه كتاب وعر وصعب، لكنه رحب وفيه تناقضات ومواضيع مختلفة ومتشعّبة، مثل نهر يمكن أن تحمّله كل شيء. السيجارة كائن هشّ.
* لكن أليست السيجارة كائناً قوياً، ولديها مدخنون وشهرة؟ أليست كائناً رحباً أيضاً؟ هل تعتقد أن “بلا أثر يذكر” يمكن أن يُظلَم بصدوره إلى جانب “دفتر سيجارة”؟
– هذا صحيح. معك حق. ربما أنا أخطأت عندما نشرتهما معاً. لكن أصعب شيء في الشعر أن تكتب عن مواضيع شائعة. كالحب مثلاً. يصعب أن تكتب عن الحب وتأخذ مسافة خاصة بك. لأن العاطفة القوية تأخذ من قوة النص. التدفق الأول يسحب من وهج النص. عندما يكتب الحب نفسه يضعف الشاعر.
* لقد اصبت عصفورين بحجر واحد، فالموضوع الذي كتبت عنه شائع، لكن لم يسبقك أحد الى الكتابة عنه…
– صحيح، كتبت بعض القصائد عن السيجارة، لكن لم يخصص أحد السيجارة بكتاب. صحيح، الموضوع شائع والكتابة عنه غير موجودة، وهذا الأمر يفيدني. تحتاج إلى خبرة وثقافة واهتمام وصبر طويل. عندما تكتب مواضيع شائعة لا بدّ أن تتقاطع مع شعراء كثيرين كتبوا عن الموضوع نفسه. كل من كتب عن الحبّ تقاطع مع آخرين، نزار قباني تقاطع مع كثيرين. كلنا تقاطعنا، وهذا ليس عيباً.
* لكن موقفك من نزار قباني كان مختلفاً. كنت تقول دائماً إنه لا يعنيك كشاعر.
– في البدء نعم. اليوم يعنيني كل شاعر. في بداياتنا كنا ننظّر لأن عصرنا كان عصراً إيديولوجيا. كانت النظرية مهمة جداً في القرن العشرين. في هذا الوقت كنت ايديولوجياً في الثقافة إلى حد ما من دون أن أعرف ربما. الحداثة إيديولوجيا. الحداثة أنتجت التخلف والديموقراطية انتجت الإستبداد (نتذكر النازية التي طلعت من قلب الديموقراطية الأوروبية). ما كان جديداً صار قديماً. كنا نصنّف الشعراء بحسب مواقفنا النظرية. من لا يكتب مثلي ليس شاعراً. أنا اليوم أعتبر أن كل شاعر لديه حدّ ما من الإجادة، صار يعني لي. لأنني صرت أتعاطى مع الشاعر بناء على تجربته، وليس بناء على منطقي أنا. كنت أحاكم نزار قباني بحسب أفكاري أنا.
لم يعد هناك شيء اسمه قصيدة نثر
* أنت تطالبنا بالكفّ عن النقد؟
– لا، لا. يمكن أن تنتقده كما تشاء. لكن في أيامنا كان النقد جاهزاً. وأنا أخطأت في أمر آخر، عندما قلت إن قصيدة النثر هي آخر المطاف، وهذا منطق حتمي. وهذا يضعني في الخانة نفسها مع ما يقوله أصحاب النظرية المقابلة، أي أن أفكاري تصير جاهزة ومعلّبة. يمكن أن يظهر شاعر كبير في ما بعد ويقوم بالتجريب في الشعر العمودي، وينتج من ذلك قصيدة رائعة. يمكن أن أقوم شخصياً بتجريب الشعر العمودي بطريقة خاصة. لم يعد هناك وجود لشيء اسمه قصيدة نثر. لم يعد هناك شيء اسمه شعر بالنسبة إلى المفاهيم القديمة. الشعر صار واسعاً جداً. اليوم، تصنيف الشعر صار من الماضي. البيانات هي قتل الشعر. جبران خليل جبران كتب قصيدة نثر، النفّري أيضاً، علي بن أبي طالب، أبو حيان التوحيدي لديه نصوص سوريالية لم يكتبها بروتون ولا غيره من السورياليين. النصّ ينقسم موزوناً وغير موزون. هناك روايات اعدّها قصائد. صموئيل بيكيت أعتبره شاعراً كبيراً. بيكيت كتب القصائد، وكان شعره رديئاً، شعره الحقيقي في مسرحه.
* بناء على ما تقدّم، كيف تصنّف نزار قباني اليوم؟
– نزار لديه لغته وأسلوبه وطريقته. شاعر. مفهومه للشعر بسيط، بين المباشرة واللعب على اللغة. تأثر بالياس أبو شبكة وميشال طراد. تأثر بالمدرسة اللبنانية. لكن، أوجد اسلوبه الخاص. لديه أشياء جميلة.
* ما أناقشه معك، هو كيفية النقد، كيف نقوم بنقد نزار قباني، ما هي المعايير لذلك؟
– ليس هناك معايير جاهزة. الكوارث أتتنا من المعايير الجاهزة. كل مدرسة نقدية مناسبية وعابرة. أدخل إلى نزار من أدواتي وخبرتي، وأراه من منطقه، أين نجح وأين فشل.
التكريس مقبرة الشعراء
* من الواضح أنك تخضع النقد للتجريب، وهذا جيد، لكن دعني اسألك، بناء على ما تطرحه، كيف يتم نقد شعر نزار قباني؟
– لماذا يحب الناس أبا نواس؟ لأنه كتب حياته. هذا نفسه ينطبق على نزار قباني. أين كتب حياته ونفسه، وأين كتب تملّقاً للمجتمع؟ وهذه وقعنا فيها كلنا. كل الشعراء سقطوا في هذا الفخ. أتعامل مع نزار أو غيره من منطقه هو. نزار لديه نثر جميل جداً. نزار أتى في زمن ايديولوجي. حاربته الايديولوجيا، لأنه كان يمينياً، كان اليسار هو المسيطر على الإعلام، من هنا حورب كثيراً من الإعلام. الشعور بالعظمة مقتل الشاعر. التكريس عندنا مقبرة الشعراء. يجب على الشاعر أن يرفض التكريس. التكريس مثل الإقطاع. التكريس من كلمة كرسي. أكبر خطأ هو المفاضلة بين الشعراء. كلمة “أشعر الشعراء” تميتني من الضحك، وعائدة الى التراث الجاهلي
والقبلي.
* لماذا لا تقرأ شعراً في الأمسيات؟
– أنا وضعت نفسي في قفص: المكان الوحيد للشعر هو الكتاب. حتى لوحة تشكيلية داخل الكتاب الشعري لا أضع، حتى الموسيقى لا أقبل أن ترافق الشعر. المنبر إرهاب على الشعر. هناك شعراء كبار لا يتقنون الإلقاء، يُظلَمون على المنابر، فيما هناك شعراء تافهون يستحوذون على الإهتمام من وراء إلقائهم. ولكن أنا ابن مسرح، أنا أمسرح الشعر، أكثر من قوله. قبلت أن اقرأ الشعر مرتين في باريس ومرة في مصر ومرة في الأردن. تلقيت دعوات كثيرة وكنت أرفضها. كنت افضل الكلام عن الشعر، لا القاءه. كنت أعتبر أن بعض النصوص لا يمكن إلقاؤها. فالقصيدة الحديثة قصيدة مركبة، ولا يمكن أن تُفهَم إذا سُمعت للمرة الأولى. في باريس اخترت “كشهر طويل من العشق” مرتين وكل مرة بطريقة مختلفة. أنا ابن المسرح، لا تنس ذلك. وثمة أمر إضافي: أنا لم اقم يوماً بالمشاركة في أي امسية شعرية أو ندوات أو مهرجانات في لبنان، لكي أهرب من الأجواء الطائفية هنا التي تعشش في الثقافة.
* يلاحظ في كتاباتك أن هناك تعددية أطياف وأشخاص، وهناك خلفية مسرحية تمسك بالنص الشعري، كيف تشرح ذلك؟
– استفدت من المسرح والسينما كثيراً، لأنني شاهدت في حياتي أكثر من ألف مسرحية وقرأت ألوف النصوص المسرحية، في “نفاد الأحوال” لفت نظري محمود درويش إلى المسرحة.
الشعراء الشباب يكتبون حيواتهم وأجسادهم
* انت متابع للإنتاجات الشبابية الجديدة، كيف تقيّمها؟
– الشعراء الشباب يحاولون أن يكتبوا كلّ تجربته، لم يصلوا بعد، ولكنهم يجرّبون. هم أكثر حرية منا. نحن كنا مكبّلين بالمدارس والأفكار، وكنا ننظّر كثيراً. وكل ذلك زال، مع القضايا الكبيرة. الشعراء اليوم صاروا أكثر حرية، لا يحملون أعباء الالتزام الحزبي والضيق واسترضاء الجماهير، بمعناها الكتلّي التاريخي، التي لم تعد همّ الشعراء اليوم. يكتبون أنفسهم وحيواتهم وأجسادهم. وهذا شيء مهم جداً. لكن هناك نقص. عندما تذهب الايديولوجيا، لا يعود للشاعر ما يستند إليه، يصير وحيداً، إما أنه يعرف الكتابة وإما لا يعرف، وهذا صعب جداً. من هنا ضرورة أن يقرأ الشعراء الشباب أكثر. ثمة شعراء يمتدحون الشعراء الشباب بالمفرد، ويهجونهم بالجمع. أنا أنصح الشباب من الشعراء أن يتعلموا لغات أجنبية لأنها المفاتيح للشعر العالمي العظيم، وكذلك الإطلاع على التراث العربي القديم والجديد.
* هل تعتقد أن الإنترنت والوسائل البصرية من تلفزيون وسينما يمكن أن تغني عن الكتاب؟
– ربما، هذه الوسائل هي مصدر للمعلومات، المهم كيفية الإستفادة من هذه المعلومات المتدفقة علينا. الإنترنت سهّلت الحصول على المعرفة. قبل سنوات كنا نحتاج إلى أشهر وأحياناً سنوات لنحصل على كتب من الخارج، اليوم يمكن أن نفعل ذلك في ساعات عبر كبسة زرّ. لكن هذا لا يكفي. لا الكتاب ولا الإنترنت يكفيان. هناك الحياة والتجارب الشخصية.
* ماذا يعني لك التجريب كأسلوب كتابة وحياة؟
– التجريب ليس نظرية. لا أستطيع أن أشرح عنه. هو ممارسة. زال عصر النظريات وحلّ التجريب مكانها. التجريب هو ألاّ تقلّد الآخرين وألاّ تقلّد نفسك. التجريب في المسرح قام على الإرتجال، التمارين التي يقوم بها الممثلون على المسرح هي تجريب للوصول إلى الشكل النهائي. هذا ما أفعله في النص الشعري. أكتب وأنقّح وأعيد حتى أصل إلى بنية يمكن أن اسمّيها نهائية. وبعد نشر قصائدي لا أعيد قراءتها. أضجر أحياناً عندما اقرأ نصوصي، أصاب بالنعاس وأنام. هذه كائنات انفصلت عني ولا علاقة لي بها بعدما صارت كائنات مستقلة بذاتها.
* ألا تخاف أن يتحول التجريب إلى نظرية؟
– لا، لا. التجريب هو الحرية. من يعتقد أن نصه اكتمل يفقد حريته. التجريب هو القلق. التجريب هو نفي الذات، وتمزيقها. التجريب هو اللانهائي. التجريب هو الوصول إلى العدم. من هنا أقول إن الكتابة هي العدم الخلاّق. لا حدود للتجريب. ولهذا، الشعراء الجدد أكثر حرية منا. أنا أحلم بقصيدة لا تبدأ ولا تنتهي، فيها جنون وفوضى، ولامحدودية. اللاتجريب هو الركود والمحدودية. الشعر المكرر هو الموت. التجريب هو إماتة الموت. هناك شعراء يكررون ذاتهم لكن عمودياً، وهذا التكرار إيجابي، لأنه عميق، كسان جون برس، أندره دو بوشيه. أنا كتبت كتبي الأربعة الأخيرة “بلا أثر يذكر”، “دفتر سيجارة”، “حديقة المنفى العالي”، و”حجرة مليئة بالصمت” في وقت واحد. كان شيئاً أشبه بالجنون. إنها المرة الأولى أقوم فيها بأمر مشابه.
* هل فكرت في كتابة رواية؟
– لا، أنا انحزت إلى المسرح. لا أجيد كتابة الرواية.
من قال إن الشاعر مهذّب؟
* أثيرت في الفترة الأخيرة مآخذ كثيرة على مقالاتك، وعلى كتاباتك السياسية المباشرة…
– أولاً يجب أن تنتبه إلى ظروفي. أنا شاعر والشعراء يغضبون. ميشال عون يشتم الناس يومياً. وشرائح كبيرة من الناس تخوّن وتهدّد، وهناك اغتيالات وترويع وغزوات، وهذا كله يؤثر فيك. أنا لست قديساً. أخذوا عليّ بعض العبارات غير المهذبة بحق عون. من قال إن الشاعر مهذّب؟ الشاعر يغضب، من قال إن ابا نواس مهذب؟ أو شكسبير مهذّب. كنا في الجامعة نقول في التظاهرات عن النواب: “تسعة وتسعين حرامي”. الحقيقة في موضوع ميشال عون، هناك شعراء ومثقفون انحازوا إلى عون وحاولوا فتح معارك معي في خلال معركتي مع ميشال عون وهذا لا يجوز. الشعر هو أقصى البذاءة في وجه المجتمع المريض والمتخلف. الشعر تمرّد. أنا لا أقوم بحسابات قبل أن أكتب المقالة. أقول رأيي كما هو.
* في رأيك، ما هي مشكلة المسرح في لبنان؟
– المسرح يحتاج إلى إنتاج. ثمة مسرحيون شباب كثر موهوبون لكن فرص الإستمرار ضئيلة. الدولة عندنا لا تدعم المسرح. لا تخصص موازنة للثقافة. يحتاج المسرح إلى اعادة نظر في كل معاهد الفنون في لبنان، لجهة المواد وأطر التعليم.
* لماذا توقفت عن كتابة المسرح؟
– الشعر قضية فردية. لا يحتاج إلى موازنة، بينما المسرح عمل جماعي، يحتاج إلى تفرّغ وممثلين وثياب وإضاءة وجمهور وفلوس. لهذا لا أكتب المسرح. لا يوجد لدينا مسرح قومي في المدينة. ضمن مسيرة الإعمار، يجب أن يبنوا المسارح. المسارح الموجودة لا تكفي. المسرح التجريبي لا يحميه الجمهور، يجب أن تحميه الدولة والمؤسسات، بينما المسرح التجاري لا يحتاج إلى من يحميه بسبب طابعه التجاري والإستهلاكي.
* أنت متابع للحراك الشعري في فرنسا، كيف تقيّم الشعر الفرنسي حالياً، ولماذا لا تترجم الشعراء الجدد في فرنسا؟
– أنا أقوم بالترجمة في الصحف والمجلات، وأحضّر طبعة ثالثة من كتاب الشعر الفرنسي الحديث، سأضيف إليها مئة شاعر جديداً. وستكون له مقدمة جديدة أرصد فيها الشعر الفرنسي ومكانته في العالم. في فرنسا زال زمن الرواد. وهنا أيضاً حصل الأمر نفسه. ذهب زمن الأصنام والروّاد. ذهب زمن أنبياء الثقافة والحمد لله. الريادة أعدمت شعراء كثراً. في بيروت الشعراء الشباب متمردون على الروّاد. وإذا كان الشباب يعتبرونني صنماً، فليحطّموني. فما أجمل الشعر بلا تماثيل ولا بخور ولا قديسين ولا ملعونين ولا روّاد… مكرّسين على كراسيهم المستكرسة ¶
يومذاك كانت ساحة البرج
مقصدنا، كان أبي يعطينا ليرة نهار الأحد، وكنت
أبيع قناني العرق الفارغة أجمعها من دكان جدي، وأشتري بليرتين الكثير من الكتب والمجلات، وتعرفت إلى المكتبة الوطنية في البرج، مكان مجلس النواب حالياً. كانت بيروت الحقيقية، وليست بيروت الميليشيات. كانت بيروت
الحرية، المرأة كانت حرة. المجتمع كان في مرحلة خروج، اليوم عاد إلى حيث خرج. وكان هناك الكثير من المقاهي في بيروت. وهي أمكنة غاية
في الأهمية. أنا تربيت في المقاهي.
في الجامعة أسّسنا حركة الوعي.
المرحلة الأهم في حياتي هي مرحلة
كلية التربية في الجامعة اللبنانية. كانت جامعة حقيقية وليست كهذه الموجودة اليوم. يجب أن يقفلوها هذه الجامعة
المنقسمة اليوم فروعاً وطوائف. كانت مرحلة نضالية.
علّمتني الجامعة كل شيء.
المقهى صار من عادات جسمي.
من عادات أفكاري ويديّ وحواسي وبصري. هو نافذة
المدينة. عندما لا تكون المقاهي موجودة، تنغلق المدينة. المقاهي هي الحوار وقبول الآخر. المقاهي في المدينة لا
تسألك عن أصلك وفصلك. في الحروب تقفل المقاهي،
والمدينة. الأنظمة العربية ريّفت المدن العربية.
الميليشيات ريّفت المدينة ولا تزال تريّفها…
التجريب هو الحرية. من يعتقد
أن نصه اكتمل يفقد حريته. التجريب هو القلق.
هو نفي الذات، وتمزيقها. هو اللانهائي. وهو الوصول
إلى العدم. من هنا أقول إن الكتابة هي
العدم الخلاّق.
هذا ما أفعله في النص الشعري.
أكتب وأنقّح وأعيد حتى أصل إلى بنية يمكن أن أسمّيها
نهائية. وبعد نشر قصائدي لا أعيد قراءتها. أضجر
أحياناً عندما اقرأ نصوصي، أصاب بالنعاس وأنام. هذه
كائنات انفصلت عني ولا علاقة لي بها بعدما صارت
كائنات مستقلة بذاتها.
رامي الأمين ومازن معروف
ملحق النهار الثقافي



